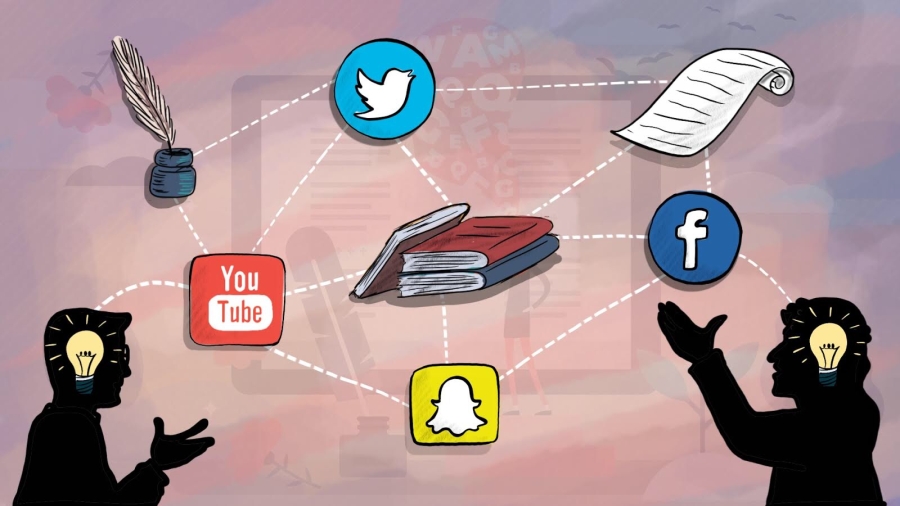- 5 آيار 2020
- ثقافيات
بقلم : احمد العباس
لم يكن من المفاجئ أن يتحول مجمل النشاط الثقافي حول العالم إلى شكل من أشكال التواصل عن بُعد عبر تطبيقات «زووم» و«فيسبوك» و«إنستغرام»... وغيرها من منصات الأونلاين، حيث سرّعت جائحة «كورونا» هذا الخيار التواصلي بين المشتغلين في الحقل الثقافي حول العالم، وصار لزاماً أدبياً وتقنياً عليهم التعامل مع هذه المنابر التكنولوجية حقيقةً مؤكدةً للحضور في مسرح آخذ في الاعتماد شيئا فشيئاً على مبتكرات فائقة الحداثة؛ إذ يُفترض بالمثقف أن يتجاوب مع هذه المكتسبات الحضارية لئلا يُصنّف في خانة الأُميّة التكنولوجية. وهو حضور ليس على تلك الدرجة من التعقيد المعرفي بقدر ما يتطلب حالة من الاستعداد النفسي لتقبُّل فكرة التحول من التواصل الحي المباشر مع الجمهور، إلى صيغة التماسّ مع المتلقين عن بُعد.
المؤسسات الثقافية باختلاف توجهاتها الرسمية وشبه الرسمية وكذلك الجماعات الأدبية والأفراد بمختلف انتماءاتهم وكفاءاتهم، سارعوا إلى إعداد برامج بثّ مباشر لندوات فكرية ولقاءات ثقافية وأمسيات شعرية ومعارض تشكيلية... وهكذا، بحيث لم يعد بمقدور المتلقي اللحاق بتلك البرامج وفحص المهم والأهم منها، وذلك بسبب كثرة وكثافة البثّ. وهذا وجه من وجوه الحيوية التي تهبها المنصات الثقافية الأونلاينية، وفي المقابل قد تؤدي تلك الجرعات العالية من البثّ الثقافي إلى حالة من الفوضى، وإهدار القيمة الثقافية، وذلك بسبب استسهال فكرة تنظيم الأحداث الثقافية، وفتح الباب على اتساعه لأشباه المثقفين لاحتلال تلك المنصات وإتلاف صلاحيتها في وقت قياسي. وهو ما حدث بالفعل من قبل بعض المفتونين بالحضور لمجرد الحضور، حيث دبروا لهم إطلالات يومية فيها من اللغو والثرثرة أكثر مما بها من الثقافة.
خارج المنصات الأونلاينية كان القائمون على النشاط الثقافي يشتكون من ضآلة الحضور الجماهيري، وبالمقابل كان الجمهور يتبرم بسبب تواضع الطرح الثقافي ورداءة النصوص الشعرية المُجترّة. وهكذا حدثت القطيعة الثقافية؛ ليس لهذا السبب فقط، ولكن لِمُتَوَالِيَة من الأسباب بعضها ثقافي وبعضها خارج سياق الثقافة. وعندما ظهرت اليوم فكرة المحاضرات واللقاءات الأونلاينية، تَصوّر بعض المشتغلين بالثقافة أن هذا المكتسب الحضاري سيكون بمثابة الحل السحري لإعادة التواصل مع الجمهور بمعزل عن الوسيط المكاني وتعقيداته المؤسساتية؛ إذ لا بيروقراطية تنظيمية، ولا عناء السير في الشوارع المزدحمة، ولا رقابة حتى؛ اجتماعية أو رسمية، على ما يمكن أن يقال، بل لا حاجة للمبالغة في الأناقة التي تليق بمقام المكان. وكل تلك المنظومة من الأسباب وغيرها تشجّع من دون شك على قبول الحضور الذي لا يكلف المتلقي سوى الدخول على رابط الدعوة والانضمام إلى معشر المثقفين بضغطة زر. وهذه عوامل بقدر ما تغري المثقفين بالمشاركة، ترفع منسوب الحذر من انتقال أمراض المشهد الثقافي الواقعي إلى المنصات الأونلاينية، حيث امتلأت بعض غُرف المحاضرات بعدد يفوق ما تحتمله المدة الزمنية للأمسية، الأمر الذي يحتاج إلى ضبط.
هنا يبرز السؤال حول جدية المتلقي في التعامل مع هذا النمط من الأداء الثقافي. فقد يكون راغباً بالفعل في التواصل الثقافي والتعرُّف على الأسماء الفاعلة أدبياً وفنياً، ومن دوائر معرفية أوسع بأكثر مما اعتاده ضمن دائرته الضيقة. وهو الأمر الذي يرفع بالتأكيد من قيمة البثّ الثقافي على تلك المنصات. وفي المقابل، قد لا يكون ذلك المتلقي سوى متطفل على حالة ثقافية جديدة، لا يهمه منها إلا ظهور صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، تماماً كذلك الصنف من المتلقين الذين يصرون على تقديم مداخلات سطحية في المحاضرات الواقعية وذلك من أجل الحضور لا غير، وبالتالي تنتفي قيمة وفاعلية هذه القفزة التكنولوجية، بحيث تتجدد المعضلة القديمة المتمثلة في اضمحلال عدد الجمهور وعجز المثقفين عن استقطاب المتلقين وإنْ بصورة أكثر بهرجة. بمعنى أن هذه الاحتفالية الأونلاينية لن تكون سوى لطخات ماكياجية لمشهد ثقافي مشوّه.
والملاحظ أن بعض المعنيين بالشأن الثقافي استمرأوا فكرة الحضور اليومي عبر المنصات الأونلاينية ومن دون أي اعتبار لقيمة ووجاهة الطرح الثقافي، فصاروا يسدون منافذ تلك المنصات؛ سواء عبر لقاءات أقرب ما تكون إلى الثرثرة، ومحاضرات أشبه ما تكون باستعراض عورات الذات المعرفية... حيث كثر الحديث - مثلاً - عن أدب الأوبئة، وأدب ما بعد «كورونا»، وذلك ضمن هبّة ارتجالية لملء فراغات المشهد المعطّل جراء جائحة «كورونا»؛ إذ لم يكلف معظم أولئك أنفسهم إعداد أوراق أو محاور ذات قيمة معرفية تليق بالمنصة، في الوقت الذي اجترّ فيه عدد من الشعراء وكتّاب القصة خزينهم من النصوص البائتة بشكل آلي، مدفوعين بالخوف من الصمت والفراغ من ناحية، وبحُب استعراض الذات من ناحية أخرى. ولذلك بدت الصورة أو التجربة مخيبة في جانب منها؛ ومشجّعة في جوانب أخرى يمكن البناء عليها. وهذه هي طبيعة التجريب في المكتسبات الحضارية.
ومن الطبيعي أن تندفع الذوات الأقل نضجاً وإحساساً بالمسؤولية الثقافية إلى استغلال ذلك المكتسب التكنوثقافي، مقابل تردد وربما ارتباك من قبل الذين يعون معنى ومسؤولية مواجهة الجمهور، الذين يستشعرون قيمتهم الرمزية بوصفهم مثقفين. وهذا هو ما يفسّر اجتراء بعض الأسماء على تحويل المنصة إلى عادة يومية للكلام الفارغ حول أي موضوع، مقابل فئة قليلة جداً استطاعت بالفعل أن تفتح أفقاً مبشراً في المشهد الثقافي العربي، سواء من خلال انتقاء الأسماء وتنوعها، أو على مستوى اختيار الموضوعات، حيث الأسماء الجادة، القادرة على التماسّ النشط مع الجمهور، والمضامين العصرية الثرية التي تعكس متانة المنصة وقابليتها للاستمرار ضمن استراتيجية تتجاوز لحظة «كورونا» التي استوجبت هذا الشكل من التواصل الثقافي.
والأكيد أن المنصات الأونلاينية لم تكن مجرد رد فعل طارئ على مستوجبات التباعد الاجتماعي التي فرضتها «كورونا»، بقدر ما كانت اشتغالاً تكنولوجياً استراتيجياً لتسهيل العمل والتواصل عن بُعد، وبالتالي يمكن تسجيلها من الوجهة الثقافية في سياق ترهين اللحظة الديمقراطية، وكسر صرامة ومحدودية الحيّز المدرسي، بمعنى تحويل قاعة المحاضرات إلى صالة أكثر اتساعاً وتعددية وقابلية لطرح ما لا تحتمله الصروح الأكاديمية، وإن كانت هذه الهبّة الثقافية غير محصّنة ضد موجات الشعبوانية، والعودة إلى الشفاهية، التي قد تحيل فاعلية المنصات إلى سيرك استعراضي يتحكم فيه أشباه المثقفين، بحيث تُتداول فيه مشتبهات ثقافية بدلاً من الثقافة الحقيقية.
بمقدور أي جهة، سواء كانت رسمية وغير رسمية، استثمار هذه المنصات العابرة للحدود في إعداد برامج ثقافية ذات جودة عالية، كإجراء لقاءات منتظمة ضمن برنامج ثقافي بإعداد جيد، أو بتنظيم ملتقيات بمشاركة أسماء لها وزنها ومكانتها الأدبية حول موضوعات ملّحة، أو تقديم أمسيات شعرية لشعراء يمثلون جانباً من ديوان الشعر العربي الجديد... وهكذا. وإن كان هذا لا يعني الدعوة إلى مأسسة تلك المنصات الجماهيرية والتحكم في محتوى ما تبثه من مواد ثقافية؛ إذ يمكن للصالونات الأهلية والجماعات الثقافية وأندية القراءة وحتى الأفراد، استثمار هذا المكتسب الحضاري بأقصى قدر ممكن، بحسبان أنه أحد المعطيات الحيوية للحظة الديمقراطية.
صحيفة الشرق الاوسط