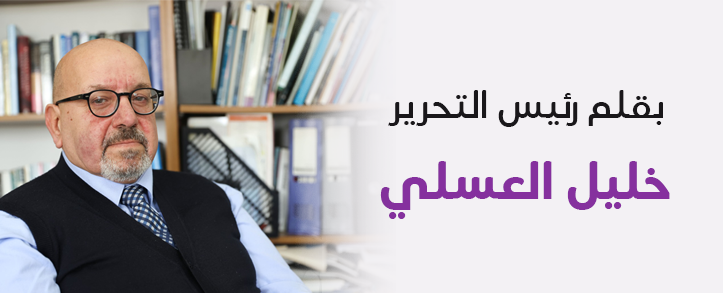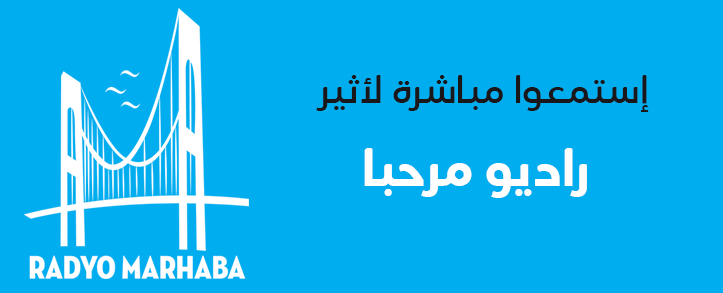- 10 تشرين أول 2025
- مقابلة خاصة
تتناول هذه المقالة واقع الوقفيات المقدسية (سواء كانت خيرية صحيحة او ذرية ) واهمية حجج حصر الإرث في القاء الضوء على النسيج الاجتماعي والثقافي للقدس، مع التركيز على سردية نسب الشيخ محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي (ت. 1734م). تلك الوقفية التي تطفو على السطح بين فترة واخرى في القدس من خلال الباحثين والمقدسيين ايضا .
ويوضح البحث الذي قام به الدكتور علي قليبو دور الوقفيات في صيانة الأنساب، وتوثيق العلاقات الأسرية، وإبراز شبكة المصاهرات التي شكّلت المجتمع المقدسي. كما يناقش اللغط التاريخي حول نسب الشيخ الخليلي، ويؤكد جذوره العميقة في التاريخ الأيوبي والمملوكي.
بقلم : د. علي قليبو
تكمن أهمية الوقفيات المقدسية ووثائق حصر الإرث في حفظ الموروث المقدسي وحماية الإرث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للقدس الشريف ضد محاولات طمسه وتزييف سرديته من قبل الدخلاء المتطفلين. في هذه الحقبة التاريخية حيث تواجه القدس خطر التهويد وطمس تاريخنا الاجتماعي من قبل الإسرائيليين والانتهازيي تكتسب وثائق حصر الإرث والتي يتوإرثها المقدسيون لأجيال أبّاً عن جد أهمية قصوى كمصدر معلومات غني وأرشيف عمراني يسرد تاريخ القدس الاجتماعي، ومن أهم هذه الوقفيات وقفية العينبوسي ووقفية البديري ووقفية الشيخ محمد الخليلي وهي موضوع مقالتنا. فنجد عبر التحقيق أن الإيرادات في هذه الوقفيات والتي تُمثّل الكثير من العمارات والمنشآت المقدسية تعود لأسر القدس العريقة والتي تتكون من أسباط تُشكّل المصاهرة أسس روابطها الاجتماعية، كما تُحدد إيراد كل فرد وفقاً لطبقته أي درجة قُرب الجدّة أو الجدّ اللذان أوقفا هذه العقارات. فما أشبه السبط الواحد بترابط أفراده عبر المصاهرة بعقد من اللؤلؤ لكل حبة موقعها وإيراداتها وفقاً لحصته أو حصتها في حصر الإرث. "النسوان شبكة" مقولة شعبية تتصل بمفهوم السبط المرتبط بالوقفيات والمُثبت بحجج حصر الإرث كما تبرزها وقفية مولانا الشيخ محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي المقدسي.
في مطلع القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، تربّع مولانا الشيخ محمد الخليلي، الشريف ذو الثقافة والثروة العظيمة، على قمة الهرم الاجتماعي للنخبة الدينية في القدس. فتنافست العائلات المقدسية المرموقة على إقامة تحالفات معه من خلال الزواج من بناته وأبنائه وأحفادهم. أنجب الشيخ محمد وزوجته أمينة خمسة أطفال فأصبحوا من خلال سلسلة من الزيجات المختلطة أسلافًا لشريحة كبيرة من المجتمع المقدسي هم بالفعل أولاد خالات. فيشمل نسلهم وفقاً لحجج حصر الإرث ,المحفوظة في محكمة القدس الشرعية, معظم العائلات المعروفة في القدس وهي: العلمي، الحسيني، نسيبة، النشاشيبي، الفتياني، أبو السعود، مؤقت، قليبو (الخليلي)، الإمام، ترجمان، الدجاني، والخالدي، وفي هذا الصدد من خلال عشرة أجيال لعبت ذريته دورًا رئيسيًا في تعزيز وتحديد شخصية وتاريخ القدس الاجتماعي العربي الإسلامي. فكان العالم محمد الخليلي وزوجته آمينة حجيج بمثابة مدرسة نسجت النهج الاجتماعي للقدس ومنحوا المدينة قيمها الإسلامية المميزة، وحب العلم والشغف بالمعرفة والجماليات والقيم التي تحكم آداب السلوك الاجتماعي، وتربية الأطفال، كما دمغت القدس بمطبخها المميز.
يكثر المدّعون والمتسللون ويسعى الكثيرون إلى إلحاق نسبهم به ويزعمون زورًا أنهم أقرباء للشيخ محمد وأنهم مستحقون للأوقاف مما يؤدي إلى خلق إشكاليات عدة أهمها تزوير تاريخ القدس الاجتماعي. فشرح القاضي محمد سرندح "إنّ موقفنا هو الحفاظ على صفاء الأنساب، وأنساب العائلات، وترتيب المستحقين. وعملنا، بالتعاون مع المحكمة الشرعية، هو إضفاء الشرعية وتوثيق الأنساب والحفاظ على صفائها".
إنّ الأوقاف وحجج حصر الإرث سجلات موضوعية لدراسة الأنساب والتاريخ الاجتماعي، فيحافظ أرشيف المحكمة الإسلامية على العلاقات الأسرية والاسباط من خلال عقود الزواج في سجلها الاجتماعي. وفقًا لهذه السجلات، يتم توثيق مراتب الأحفاد كمستحقين بدقة ولا يُسمح للمتطفلين من طلبة الجاه والنسب الشريف العبث بهذا النظام.
ويعود هذا الإشكال إلى اللغط الذي يحيط بنسب الشيخ محمد الخليلي كما نتبينه في سيرة الشيخ محمد الخليلي التميمي كما سردها الشيخ حسن عبد اللطيف الحسيني في القرن التاسع عشر والتي اعتمدها وتناقلها المؤرخين في سرديتاهم. فالصورة المرسومة، باختصار، هي لدرويش مغامر ظهر بغتة واختفى بغتة بدون نسب حيث شاءت الصدفة وأتاه الحظ وارتقى من الفقر إلى الثراء ومن ظلام الجهل إلى نور العلم والمعرفة. هذه الصورة البلاغية تجعله شخصية غامضة ومبهمة علماً أن جذور عشيرة الخليلي في القدس تعود إلى العصر الأيوبي، وعلماً أننا "آل قليبو" و"آل القطب" وفقاً لكلام الشيخ مازن أهرام امتداداً لعشيرة الخليلي في القدس ومنذ العصر الأيوبي بأمارة أن عائلة "القطب" وعائلة "قليبو" يحتفظان ببيارق الخاصة بموسم النبي موسى والذي كان صلاح الدين الأيوبي قد اسسه وخص به العائلات والعشائر المقدسية المتواجدة لتثبيت النظام الاجتماعي بعد تحرير القدس من الصليبيين.
انشطرت عشيرة الخليلي عن عشيرة التميمي المنحدرة من الصحابي تميم بن أوس الداري واستقرت منذ الفتح العمري في القدس وفي الشام كما انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي عشائر وبطون وأفخاذ أخرى انشطرت عن عشيرة التميمي الداري نذكر منهم:
آل التميمي بالخليل وأقامت عشيرة التميمي أيضاً في قرية هام وعرفوا أيضاً باسم الهامية نسبة إلى القرية، التميمي الخليلي، التميمي الداري أو الخليلي، الخطيب التميمي، المجالي، مجاهد، صرصور، سلطان، عبد الباسط، جلال، الكيال، الحلواني، المحتسب، الصاحب، فنون، عبد الباسط، سلطان، شبانة، الحليسي شاور، الربعي، اشتي، الزرو، بهية، أبو عجيلة، أبو رجب، أبو رميلة، سلهب، بيوض القصراوي، وأيضاً هناك التكروري، النابلسي، الكركي، والمصري. وفي دمشق المحاسني.
برزت عشيرة الخليلي في القدس الشريف وتركوا بصماتهم الواضحة في عمارة القدس المملوكية، ويعود الفضل إليهم في ترميم وإعمار مئذنة الغوانمة والمغاربة في الجانب الغربي لمسجد الصخرة، إذ تم ذكر أسماء الوالد فخر الدين الخليلي وابنه شرف الدين في مجلد "القدس المملوكية" لمحرره بورغوين حيث أشار إليهما (بالأمير والقاضي).
وذاع صيت قضاة ورجال الإفتاء من عشيرة الخليلي بالقدس منذ القرن الثالث عشر أي بالزمن الأيوبي ابتداءً بالقاضي شرف الدين الخليلي الذي كان ناظر أوقاف الحرمين الشريفين، فقام بترميم مئذنة باب المغاربة ، التي تُعدّ أول مئذنة تُشيّد في المسجد في عام 677 هـ/ 1278م ، وتقع على الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى، وذلك بناءً على أوامر من السلطان المملوكي لاجين. وسُميت أيضاً بالمئذنة الفخارية نسبةً إلى فخر الدين الخليلي، والد القاضي شرف الدين عبد الرحمن الخليلي الذي أشرف على بناء المبنى.
تعد مئذنة الغوانمة المئذنة الثانية التي تُشيّد في المسجد، وقد بناها المهندس المعماري القاضي شرف الدين الخليلي ما بين 1297–98م، وبُنيت بأمر من السلطان المملوكي لاجين، وتقع في الركن الشمالي الغربي من الحرم القدسي الشريف بالقرب من باب الغوانمة.
إنّ الجهل بتاريخ عمارة القدس والقبائل اللخمية التميمية في القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى العداء للتصوف في القرن العشرين، والخبث الاجتماعي والغيرة قد شوهت نسب الشيخ محمد الخليلي علماً بأن اسمه يشهد على نسبه، فجدّه كان محمد وجدّ جدّه كان شرف الدين الخليلي والذي كان ناظر الحرمين في العصر المملوكي. وهكذا أصبحت سيرة الحسيني المتوافقة مع الخطاب الصوفي مصدر لبس وتحوّلت إلى اللغط الذي اعتمده المؤرخون الفلسطينيون لاحقًا دون نقد أو بحث، ومن المفارقات أن الدكتور إسحق موسى الحسيني وهو من سبط الشيخ الخليلي (كان رحمه الله يخاطبني بلقب ابن خالتي حين عملت في شبابي في كلية الآداب بالقدس) استند في سيرته كلياً عن الشيخ محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي على سيرة حسن عبد اللطيف الحسيني الصوفية الأسطورية الطابع.
يمكن إرجاع أصول الخليلي بالتأكيد إلى ناظر الأقصى شرف الدين محمد الخليلي في القرن الثالث عشر. فكما شرح لي الشيخ مازن أهرام "إنّ الاختصار، أي اختصار سلسلة من أسماء الأب والابن الأكبر المتكررة في ذكر اسمين، أمر شائع عند دراسة الأنساب لفترات طويلة. فيتم اختصار مئتي عام من أسماء الجد والحفيد المتكررة عدديًا إلى ذكر واحد". وقد احتفظت الأجيال عبر ثلاثة قرون باسم شرف الدين وصولاً إلى القرن السادس عشر حين أنجب شرف الدين الخليلي شقيقان وهما يحيى الأول ومحمد الأول. ونظراً لشدة حبه وعشقه بالله وبرسوله وهي حالة الجذب المعروفة عند الصوفيين أطلقت عليه كنية "قليبه" وهي تصغير تحبب لكلمة قلب والتي تحولت إملائياً إلى "قليبو" في حجج حصر الإرث والوقفيات في أواخر القرن التاسع عشر
أنجب محمد الأول ثلاثة أبناء: صالح وخير ومحمد الثاني (أي مولانا الشيخ محمد الخليلي). كما أنجب شقيقه، جد عائلة قليبو، الشيخ يحيى الأول محمود شعبان والمفتي الشافعي الشيخ عبد المعطي (توفي عام 1742م)، وكان معاصرًا لمولانا محمد الخليلي (توفي عام 1734م) وإليه يعود شرف حمل البيرق وقيادة الموكب إلى النبي موسى والذي توإرثته أسرتي حتى النكبة التي قوضت النظام الاجتماعي والذي كان صلاح الدين الأيوبي قد أعاد تنظيمه.
ينحدر خط الخليلي قليبو من خط يحيى الأول عبر سلسلة من الأبناء الذين يحملون اسم يحيى، فينحدر نسبي من يحيى الثاني، الذي انتفع من وقفه ليصبح اسمي بالمحكمة الشرعية: محمد علي "حسين علي عبد الرزاق يحيى الخليلي". تزوج مولانا محمد الثاني أي الشيخ الخليلي مرتين وأنجب ثلاثة أبناء وأربع بنات شكّلوا سلالة من الورثة المنتفعين من الأوقاف الواسعة التي أوصى بها لذريته.
في القرن السادس عشر، انقسم أبناء العم في خطين متوازيين لكل منهما وقفيات وحجج إرثيه منفصلة أحدهما عن الأخرى: الأولى لورثة يحيى الأول وهم عائلة قليبو والثانية من محمد الأول اللذين احتفظوا باسم الخليلي (فكان سعد الخليلي كاتب المذكرات التي نشرها سليم تماري آخر فرد بسلالته التي انقرضت). عندما تزوج عبد الرزاق يحيى الخليلي (قليبو) من ابنة عمه صفية يوسف الخليلي أصبحنا جزءاً من السبط المقدسي وحلقة المصاهرات حتى غدت القدس مجتمعاً صغيراً مغلقاً يتكون من أبناء الخالات. وبهذه الصورة أدرجنا في حجج حصر الإرث الخاصة بسبط محمد الخليلي واستقر المقام بعائلة قليبو الخليلي في قصر الشيخ محمد في باب الساهرة حتى تمت مصادرته من قبل حكومة الانتداب عام 1922م حين تم بناء متحف روكفلر.
في إحدى مقابلاتي مع الشيخ مازن أهرام، تمكّنتُ من الوصول إلى وقفين من أوقاف الخليلي: وقف مولانا الشيخ محمد، ووقف ابن عمه الشيخ يحيى. وبهذا التوضيح قمت برسم خريطة نسب عائلة الخليلي في القدس بناءً على رتبتي ونسبتي كما هو مبين وموثق من قبل المحكمة الشرعية ونقيب الأشراف، حيث إنّ اسمي الكامل هو: "محمد علي"، حسين، علي الثاني، عبد الرزاق الثاني، علي الأول، عبد الرزاق الثاني، بن يحيى الثاني، بن الشيخ يحيى الأول الخليلي.
سليل النسب الشريف مولانا محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي ينحدر من عائلة عريقة من الفقهاء والمتكلمين. ويشير اللقب التكريمي لجده الأكبر شرف الدين إلى مكانته الدينية الرفيعة. يتكرر الاسمان الشرفيان شرف الدين وفخر الدين في عائلة الخليلي في القدس ومنذ العصر الأيوبي.
ارتقى الشيخ محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي، قاضي المذهب الشافعي في القدس وشيخ الطريقة الصوفية القادرية أولاً، ومن ثم الطريقة الخلوتية، إلى مكانة مرموقة محليًا وعالميًا، فكان يُقيم حلقات الذكر ويدرس في غرفته التي بناها فوق كهفٍ كان يتخذه مولانا خلوةً له، على المنصة العليا شمال غرب قبة الصخرة بجوار قبة الخضر. وعلى نطاق أوسع، كانت غرفته في المدرسة الأشرفية، حيث دُفن لاحقًا، تُستخدم لإقامة الندوات الدينية واستقبال مريديه وكبار العلماء والوجهاء الزوار. وهناك كان يزور مولانا كل عالم ورجل ذي شأن في زياراته إلى القدس، ومن رواياتهم نلمح فطنته وذكاءه وسعة علمه.
يصف مصطفى أسعد بن اللقيمي في حجه إلى القدس في كتابه "مواعين الأنس في زياراتي للقدس" مشهدًا يتفوق فيه علم الشيخ على الفقهاء الحاضرين. السؤال: لماذا كان على "كليم الله" أي النبي موسى أن يرتدي حجابًا لتغطية وجهه حتى لا يصاب من يراه بالعمى، بينما لم يكن النبي محمد بحاجة إلى تغطية وجهه بعد المعراج في القدس حيّر الحاضرين. أخرج مولانا الشيخ الخليلي، وهو عالم كلاسيكي، كتابًا صوفيًا لعز الدين بن عبد السلام لدعم حجته وبالتالي الرجوع إلى شرحه مع الاستشهادات المختارة. قدّم الشيخ أن النبي موسى لم يحقق بعد حالة اليقين الثبات، تغيرت تعابير وجهه "لون" وسجلت لقاءه بصوت الله المنبعث من العليقة المشتعلة. كان النبي موسى بحاجة إلى تغطية وجهه حتى لا يعمى الناظرون بنور الله المنعكس من وجهه، أمّا النبي محمد، من ناحية أخرى، فقد وصل إلى قناعة راسخة قبل المعراج، ولم يتغير لونه؛ وبالتالي لم يكن بحاجة إلى تغطية وجهه.
إن أوصاف الشيخ الخليلي في كتب الرحلات لعبد الغني النابلسي ومصطفى البكري وأسعد بن اللقيمي تُقدّم لمحة عن شيخ الطريقة الخلوتية كرجل وسيم مهيب الطلة. ويصف البكري الموكب الاحتفالي الذي رافق زيارة محمد الخليلي إلى مقام سيدنا علي في أرسوف في فلسطين، وبعد ذلك التحق المرشد بمريده إلى أحد منازله في يافا. كان الخليلي، المليء بالسعي النهم للمعرفة، مسافرًا متزودا بالعلم ومولع باقتناء الكتب لا يعرف الكلل بين دمشق والقاهرة وفي جميع أنحاء فلسطين.
ما إن توفيّ حتى أصبح شخصيةً أسطوريةً مبهمة يكتنفها الغموض. فكان آخرُ عالمٍ مسلمٍ عظيمٍ وتجوهلت مساهماته العظيمة في إثراء علم الفقه والفكر الصوفي وأهملت مجلدات الفتاوي التي اجتهد في صياغتها. لقد ترك للقدس مكتبة عظيمة، نجت منها بعض المخطوطات، حيثُ كانت متروكة في صناديق ضحيةً للامبالاة والجهل وتسرب وبيع عددٌ كبيرٌ منها وكذلك ترك إرثاً معمارياً بالقدس وبأكنافها التي سرقت وبيعت وتسربت لليهود لبناء المستوطنات، ولم يبق من أثره سوى سبط من العائلات المقدسية مشتتون في المعمورة يجهلون هويته وهويتهم مدرجون في حجج حصر الإرث. وهو تذكيرٌ آخر بالحقيقة المحزنة المتمثلة في أن القدس أصبحت مدينة مُهجّرة. إن مصير كتبه، والتلاعب بنسبه ومحاولات العبث بالوقفيات وحجج حصر الإرث بهدف تهميش تاريخها الاجتماعي وتهويدها يمهد ويهدد بأن تصبح القدس متحفاً معمارياً تاريخياً فحسب.
تقع تربة مولانا الشيخ محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي في المدرسة الأشرفية في موقعٍ بارزٍ في الصحن السفلي لقبة الصخرة حيث تبرز الغرفة، كاسرةً رتابة الرواق الغربي المتناسق، ومخالفةً إيقاع الرواق المتناسق المتقابل مع عين قاسم باشا وسبيل قلاوون.
لقد برزت المكانة الروحية والدينية لمولانا الشيخ محمد على المشهد الديني في القدس في القرن الثامن عشر. إذ بدأ الشيخ سرندح، من الزاوية الصوفية الأفغانية والقاضي في المحكمة الإسلامية، إجابته على سؤالي حول هوية جدي الأكبر الذي بدا مقامه في المسجد الأقصى غامضًا: "إنّه رجل تقي من أولياء الله الصالحين"، تابع الشيخ سرندح: "إنّه آخر رجل دين وفقيه مقدسي. لقد دُفن على مرأى من قبة الصخرة: وهو شرف يليق برجل دين في مكانته".