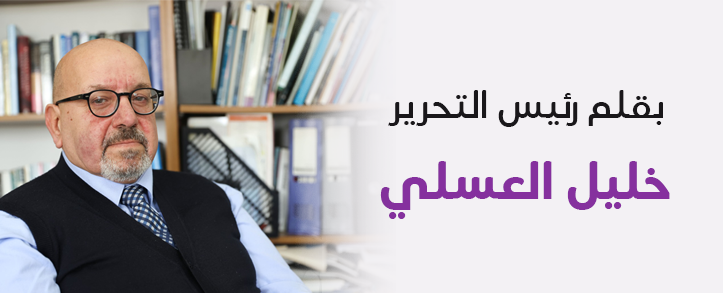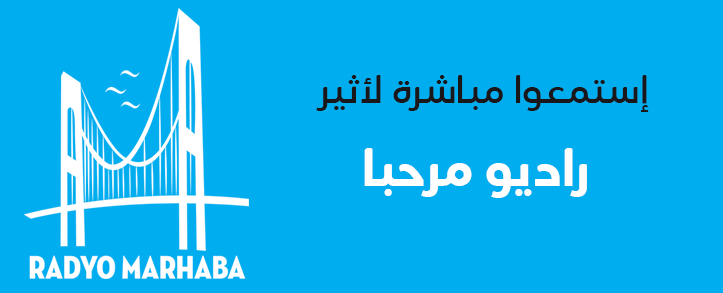- 28 تشرين أول 2025
- مقابلة خاصة
بقلم : أ.د. زيدان كفافي*
السردية هي قصة أرض وإنسان ، قدمت الأرض جميع متطلبات ومقومات الحياة للإنسان الذي تفاعل معها الإنسان وطورها لخدمته بناء على تقدمه الفكري. واختلف هذا التطور من منطقة جغرافية لأخرى بناء على المعطيات البيئية والحياتية التي توفرت له وتطوره الفكري، وباختلاف هذه المعطيات من بقعة جغرافية لأخرى ومن فترة زمنية لأخرى، وسيطرته على البيئة وجغرافية المكان الذي يعيش فيه، يمكننا قياس التقدم الحضاري. وهذا الكلام يعني سردية المكان وتفاعل الإنسان معه، أي السردية الحياتية لهذا الإنسان ومدى سيطرته على الطبيعية بمقدراته الفكرية التي تطورت عبر الأزمان . فعلى سبيل المثال لا الحصر، بدأ الإنسان حياته متنقلاً يبحث في الطبيعية عن مقوماته الحياتية، يعيش على شكل مجموعات تراوح عددها بين حوالي 15-20 شخصاً، الفرد للمجتمع والمجتمع للفرد، أي مجتمع مساواة. وأقدم الأمثلة التي وجدت في الأردن جاءت من منطقة التقاء واديي الزرقاء والظليل (السخنه ) وتعود بتاريخها لحوالي مليوني ونصف سنة من الحاضر. تطورت بعدها المجتمعات التي عاشت في الأردن اقتصادياً وفكرياً .
عاش الانسان على أرض الأردن قبل أكثر من مليون عام، وتواجد بالقرب من مصادر معيشته، وكانت على الأغلب خلال العصور الحجرية القديمة على شكل مجموعات بالقرب من أحواض المياه، مثل، الأزرق والجفر وبحيرة اللسان في حفرة الانهدام ووادي الحسا. وبعد أن استقر في مخيمات وقرى وعرف الزراعة وتدجين الحيوانات ترك لنا فيها مخلفات تدل على طبيعة حياته اليومية، والظروف البيئية التي تعايش معها وعاشها، وتركزت هذه المستقرات الثابتة وعلى الدوام بالقرب من مصادر المياه الدائمة وتوفر الأرض الصالحة للزراعة. ومع مرور الوقت عرف الناس في الأردن، كغيرها من بلدان الشرق الأدنى القديم، إضافة لصناعة الأدوات الحجرية والأواني الفخارية صناعة الأدوات والأواني من خامات النحاس، حيث تتوفر خاماته بشكل كبير في منطقة وادي عربة.
نتيجة لهذا أصبح هناك تبادل تجاري مكثف بين الأردن والمناطق المجاورة، فاصبح أهلها على تماس مع المناطق المحيطة والتي كانت قد وصلت لمرحلة التمدن والمدنية، خاصة وادي النيل ووادي الرافدين. وبدأت المدن والبلدات، مثل جاوه على الحدود الأردنية - السورية الحالية، ابتداء من منتصف الألف الرابع قبل الميلاد بالظهور. وتبع جاوه وخلال النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد ظهور المدن في الأردن، مثل مواقع خربة الزيرقون/إربد، وخربة البتراوي/ الزرقاء، وباب الذراع/ منطقة البحر الميت، والنميرة/ على وادي النميرة في الجزء الجنوبي للبحر الميت. والتي دلت البقايا المعمارية والمنقولة المكتشفة فيها على وجود قيادة سياسية فيها، وهي التي أدارت شؤون البلاد، يعني بكلمة أخرى الوصول إلى مرحلة المدينة-الدولة أو دولة المدينة.
بقي الحال على ما هو عليه حتى نهاية الألف الثاني وبداية الأول قبل الميلاد حين ظهرت دولة الأمة بعاصمة وحدود، فكانت دول العمونيين والمؤآبيين والأدوميين. وكانت هذه الدول في تصارع مع دول الجوار، وخضعت لهجوم الفراعنة، والأشوريين، والبابليين، والفرس، وانتهت كلياً بعد دخول اليونان إلى المشرق في عام 332 قبل الميلاد. لكن بالموازاة ، وفي الوقت نفسه التي كانت أجزاء من البلاد تدار من قبل اليونان ومن تبعهم من الرومان، ظهرت الدولة العربية النبطية والتي حكمت من دمشق في الشمال وحتى العلا في الحجاز في الجنوب، حتى أسقطها الإمبراطور الروماني تراجان في عام 106ميلادي. وخلال حكم الأنباط، زمن الملك الحارث الرابع، ولد السيد المسيح وأخذت الديانة المسيحية بالتغلغل بين القبائل العربية في الأردن، خاصة الغساسنة، وكانت بلدة طبقة فحل الملجأ الذي هرب إليه المسيحيين العرب من ظلم الروم. خاصة وأن الديانة المسيحية واجهت رفضاً شديداً من الوثنيين الروم، فلجأ أصحابها للتعبد في الخفاء ودون الإعلان عن مسيحيتهم خوفاً من اضطهاد الروم لهم.
وبعد أن سمح الإمبراطور روما قسطنطين الأكبر في عام 312 ميلادية بالسماح بتعدد العبادات في بلاده إعترف في عام 324 ميلادية بالديانة المسيحية ديناً رسمياً للدولة، فأعلن أهل الأردن مسيحيتهم، وبدأوا ببناء الكنائس لهم، فانتشرت على كل أرض الأردن من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه. وتواصل أهل الأردن مع جميع المناطق القريبة والبعيدة، وأسست الأبرشيات في بعض مدن الأردن. وكما نعلم فإن أهل الأردن كانوا على تواصل مع أهل مكة، خاصة من خلال القافلة التجارية بقيادة أبي سفيان، وكانت أم الرصاص "ميفعة" من المراكز الدينية المسيحية الكبيرة في المنطقة، وفيها أقام تجار مكة لبعض الوقت في حلهم وترحالهم.
انتشرت في الفترات السابقة لظهور الإسلام الكتابات بالخطوط العربية الجنوبية، والصفوية، والثمودية والآرامية، واليونانية، واللاتينية، وبعض من العربية. ويستطيع المتخصص أن يقرأ هذه النصوص المكتوبة في النقوش على الصخر، والنقد، والورق. ومن أهم الكتابات التي كشف النقاب عنها هي برديات البتراء المؤرخة إلى القرن السادس الميلادي، والتي يعكس مضمونها مدى التقدم الحضاري التي وصل إليها مجتمع العرب في ذلك الوقت.
بقي الحال في الأردن كما هو عليه حتى دخول الإسلام للمنطقة، وكانت القصور الصحراوية الأموية في البادية الأردنية، كما وبنيت المساجد جنباً إلى جنب مع الكنائس، ومن أهم هذه المساجد "مسجد القسطل". وإذا كانت الأردن لم تلعب دوراً في الفترة الأموية، إلاّ أن جبل التحكيم بين علي ومعاوية كان في أذرح/معان، كما أن بلدة الحميمة في المنطقة نفسها كانت منطلق الدعوة العباسية. وعلى الرغم من هذا إلاّ أن الأردن وللأسف لم يلق العناية الكافية والاهتمام من الخلفاء العباسيين، فجاءت الآثار من هذه الفترة قليلة جداً مقارنة مع الفترات التي سبقتها. لكن هذا لم يمنع أنه قد شهد اهتماماً بالفترات اللاحقة، خاصة في زمن الأيوبيين والمماليك، حيث شهد الأردن في الفترة الأولى بناء القلاع، مثل عجلون، والكرك، والشوبك، كما شهد انتعاشاً اقتصادياً، حيث معاصر السكر في غور الأردن وغور الصافي. وبعد هذا شهد الأردن انتكاسة حضارية في الفترة العثمانية (1516 - 1917م)، حتى بداية تأسيس الإمارة في عام 1921م على يد الهاشميين، وكان الملك المؤسس عبدالله الأول هو مؤسسها.
السردية هي قصة حضارية:
كما اشرنا أعلاه، فإن تاريخ الحضارة هو تاريخ صراع الإنسان مع البيئة وتفاعله معها، فالحضارة هي وليدة الإنسان والبيئة معاً. ولكن حتى تنشأ الحضارة وتنمو وتزدهر لا بد لها من توافر بعض الشروط المناسبة كالشروط الجغرافية والاقتصادية والسياسية والفكرية والاجتماعية وغيرها. فالبيئة الطبيعية المناسبة في منطقة ما، كخصوبة التربة وتوافر المياه تساعد على قيام حضارة في تلك المنطقة وازدهارها. ومن المعلوم إن من أقدم الحضارات الإنسانية في العالم العربي نشأت على أودية الفرات والنيل، حيث قدمت الطبيعة الشروط الأساسية لقيام الحضارة، ألا وهي التربة الخصبة والمياه الغزيرة. كذلك فإن الموقع الجغرافي قد يؤدي إلى قيام حضارة أو نهايتها، مثل البتراء وتدمر ودويلات المدن الايطالية قبل الاكتشافات الجغرافية الكبرى. فقد كان السبب الأساسي في قيام الحضارة وازدهارها في مدينتي البتراء وتدمر، وقوعهما على طرق التجارة العالمية التي كانت تربط الشرق بأوروبا. وعندما تحولت هذه الطرق عنهما تراجعت هاتان المدينتان، وانهارت حضارتاهما، أما دويلات المدن الإيطالية كالبندقية وجنوة، فقد انهار احتكارها لتجارة التوابل عبر الشرق العربي بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح في العام 1484م، ووصول فاسكو داغاما إلى الهند في العام 1498م.
كما أن الشروط الاقتصادية أساسية لنشوء الحضارة وتقدمها، والإنسان لا يمكن أن ينتقل إلى مرحلة الحضارة إلا بالاستقرار أولاً، ومن ثم ممارسة الزراعة، وفيما بعد الحِرف (المهن) والتجارة.
ولكن الشروط الجغرافية والاقتصادية لا تكفي وحدها لتكوين حضارة، بل لا بد أيضاً من توافر شروط سياسية، كوجود نظام سياسي يحمي الجماعة، وشروط أخلاقية وفكرية توجه الناس في الحياة، وذلك عن طريق التربية والتعليم، وشروط اجتماعية كوجود نظام اجتماعي سليم.
ونستطيع القول أنه بالإضافة للشروط الداخلية لنشوء الحضارة وتطورها هناك بعض الشروط الخارجية، ومنها الاتصالات الخارجية التي تكون إما سلمية عن طريق التجارة والهجرة والسياحة والاختلاط، أو حربية عن طريق الغزو والفتح والحكم الأجنبي. وقد تكون نتائج الغزو على الحضارة والاتصال الحضاري أحيانا سلبية وأحياناً إيجابية، فالغزو قد يعطي ويأخذ ويطور كالفتوحات العربية الإسلامية مثلاً، أو يهدم ويقضي على حضارة الشعوب المغلوبة كغزوات المغول على بغداد في القرن الثالث عشر، أو غارات البرابرة الجرمان على الامبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي، وقد يكون لها تأثير إيجابي كالفتوحات العربية الإسلامية التي نشرت الحضارة في بقاع كثيرة من العالم. وقد لا يكون الانتقال الحضاري من بلد إلى بلد ثان مباشرا، وإنما قد يتم عن طريق بلد ثالث: كانتقال الحضارة العربية إلى أوروبا عن طريق أسبانيا وصقلية والمدن الإيطالية ، أو انتقال حضارة الصين والهند القديمة إلى أوروبا عن طريق الفرس والعرب، أو الاتصال الحضاري بين مصر القديمة وبلاد النهرين عن طريق سورية مثلاً.
إن قيام الحضارة ليس بحاجة إلى شروط عرقية، إذ يمكن أن تقوم على يد أي شعب من الشعوب، وفي أي مكان عندما تتوفر الشروط المناسبة. فقد ظهرت الحضارة في العصور القديمة مثلاً في مصر، وبلاد الرافدين، وبلاد الشام والهند والصين وإيران. وتألقت الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى. إن الحضارة ليست من صنع عرق معين، وليس لها وطن محدد، وإنما هي نتاج متكامل للشعوب كلها تجمّع مع الزمن، واتخذ أشكالاً أرقى من التي كانت سائدة قبلاً. فحضارة كل شعب تعتمد على حضارات الشعوب السابقة، وتضيف إليها، ليعلو بذلك صرح الحضارة الإنسانية. فالحضارة الإغريقية والرومانية أخذت واستفادت من حضارات المشرق العربي القديم (مصر والعراق وبلاد الشام)، واقتبست الحضارة العربية الإسلامية عن الحضارة الإغريقية وحضارات الهند والصين وبلاد فارس، وأضافت وطورت أشياء جديدة، واعتمدت الحضارة الأوروبية الحديثة، عند قيامها، على منجزات الحضارة العربية الإسلامية، ,أخذت عنها أشياء كثيرة.
من وحي السردية الأردنية:
شكّل مفهوم السردية اختلافاً في التفسير بين كتّابها والجهات الداعمة والمنفذة لكتابتها. فمنهم من رأى أن تكون شاملة متكاملة تضم جميع النشاطات الحياتية والتطورات الفكرية التي تمت في بلد ما، ومنهم من جادل بأنها يجب أن تركز حول تفاعل الانسان مع الأرض والبيئة ومقدار سيطرته عليها، وجاء ثالث بضرورة التركيز على الفترات الحديثة والمعاصرة. وبرأينا أن السردية يجب أن تشمل جميع النواحي ، لكن على شكل مجلدات منفصلة ومتصلة بنفس الوقت ، ويكون كل مجلد بعنوان منفصل عن الآخر، وتشرف على كتابته هيئة تحرير، ويستكتب فيه كتّاب من ألمعية القوم معروفون بانتمائهم وولائهم للوطن يعتمدون المصادر العلمية الأصلية في كتابة أبحاثهم، ويبتعدون عن التحيز والتسيّس غير المرغوب. إذ أن كتابة السردية تقوم لعدة أسباب، من أهمها:
1. زيادة الوعي بين أهل الوطن ، وخاصة فئة الشباب ، بتاريخ وطنهم، مما يعزز الانتساب والانتماء له.
2. نشر المعرفة بالأردن بين مواطنيه ، وبني قومه من العرب، ومن غير العرب بتاريخ الأردن وحضارته ومنجزاته، وأنها متصلة وغير منفصلة، وأثرت وتأثرت بما حولها.
3. حفظ حقوق الوطن بكتابة تاريخه وحقوقه الوطنية من التدخلات الخارجية والتفسيرات المشوهة.
إن تحديد الجهة المخاطبة من كتابة السردية تحدد لغة الخطاب، ومستوى النص المكتوب. أي بمعنى هل تكون عربية فصحى تخاطب الأكاديميين والمثقفين؟ أم سلسة مفهومة لجميع المستويات الثقافية، والأعمار ؟ هل نكتبها بشكل روائي؟ أم نص كتابي تاريخي؟ كل هذه الأسئلة بحاجة لإجابة من الجهة المنفذة لكتابة السردية.
والأهم من هذا وذاك "كاتب النص"، فهل كل استاذ جامعي يستطيع كتابة النص المطلوب؟ الجواب "نعم"، لكن "كيف؟"
نهاية الكلام، أكرر بأن كتابة السردية يجب أن تكون متصلة، أي مثل البناء القوي، أعلاها يعتمد على أسفلها من حيث البناء الحضاري، وأن تبدأ من الأساس ، مثل أساس المبنى، وتنتهي بالحاضر، لا أن نختصر فترات حضارية لحساب الأخرى. ولنوضح الأمر أكثر، أن جغرافية الأردن متصلة بالبلدان العربية المحيطة بها، كما أن حدود الأوطان متحركة مما أدى إلى تعدد الأنساب والأعراق فيه وتغيرهم وتحولهم من زمن لآخر.
كما أن أناس الذين عاشوا ويعيشون على أرضه هم من أعراق وأجناس وديانات وطبقات حضارية واجتماعية واقتصادية ، ومن أصول مختلفة. إن هذه الفسيفسائية السكانية هي التي تميز الأردن عن غيره من البلدان الأخرى. من هنا لا بد من أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند كتابة السردية الأردنية. وهذا الذي نادت به "ثورة الحسين بن علي الكبرى" أو "النهضة العربية"، فالجيش الأردني هو "الجيش العربي" الذي دافع عن فلسطين عامة والقدس خاصة. هذه ثورة الهاشميين العربية والتي يجب أن تؤخذ كنموذج للسردية الأردنية، والعربية الأخرى.
لقد أعطى الأردن الفرصة لجميع الأقوام المحيطة به الحضن الدافئ والأمن والأمان، وكان هذا قبل حوالي تسعة آلاف سنة من الآن عندما عمّ قحط غربي النهر فجاء أهله إلى شرقيه فتكونت عندنا الكبيرة بمساحاتها وعد سكانها، مثل، أبو الصوان/جرش، وعين غزال/عمان، ووادي شعيب/ السلط، والبسطة/ معان، والبيضا/ البترا، وغيرها. ألم أقل لكم يا سادة أن تاريخ الأردن متصل ولا ينازعه ويطاوله أحد، فهو الأمين القوي على سكانه.
والله من وراء القصد
* باحث مستقل والرئيس الاسبق لجامعة اليرموك