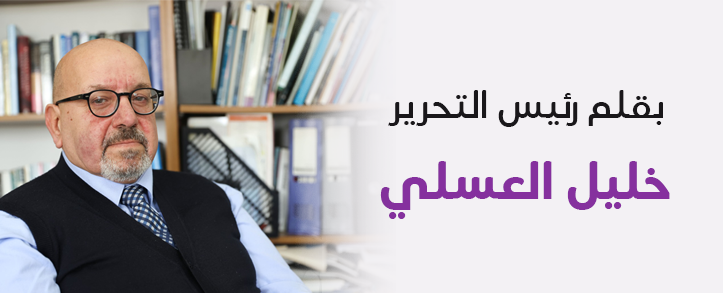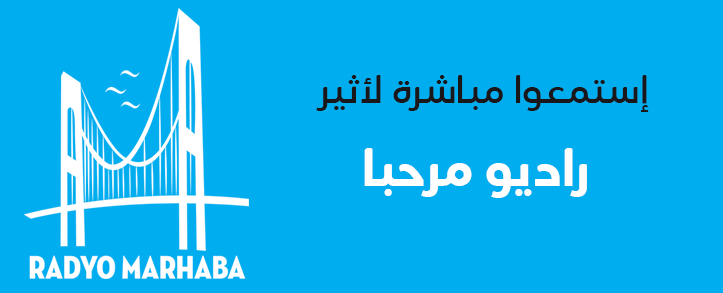- 9 تشرين أول 2016
- ثقافيات
بقلم : محمد تركي الربيعو
يعرف بعض علماء الاجتماع الموت بوصفه يمثل طقس عبور من حالة وجودية إلى حالة وجودية أخرى، سواء أكان ذلك للميت أو لمن افتقده.
ففي أثناء مرحلة الموت وقبل دفن جثمان المتوفى، غالباً ما تعيش جثته حالة أقرب إلى ما يدعوها جورجيو أغامبين بـ»موقع التباس» بين لحظتي إعلان الموت والمثوى الأخير، كما يكون خلالها جسد الميت عرضة للتفاعلات الاجتماعية والسياسية داخل مجتمعه. وقد قام أغامبين بدراسة مرحلة الالتباس تلك من خلال إجراء تحليل اجتماعي ـ سياسي للطريقة التي عبرها يسير الموت في إطار مؤسسات الدولة الحاكمة، حيث اكتشف من خلال هذه القراءة أن نفوذ الدولة وسيطرتها لم يعد مقتصراً على إعادة صنع وإنتاج أجساد رعاياها الأحياء، بل أخذ يشمل كذلك إعادة تكريس وتشكيل الأجساد الميتة التي تفارق الحياة داخل حدوده ومجاله.
في هذا السياق، يمكن أن نشير إلى بعض المحاولات التي انشغلت بمسألة الجسد والموت داخل عوالمنا العربية، مثل دراسات أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية علي زيعور، والباحثة اللبنانية منى فياض، وكذلك الدراسات المهمة والغنية للأنثروبولوجي الفلسطيني إسماعيل الناشف، التي تطرقت إلى دراسة الاقتصاد السياسي للموت ولجسد الميت الفلسطيني، ولجسد الاستشهادي داخل الحياة الاجتماعية الفلسطينية. ومن بين المحاولات الجادة والجديدة على مستوى المقاربة حيال الموت وعلاقته بالسلطة السياسية، يمكن أن نشير هنا إلى الدراسة التي أعدتها كل من الباحثة الفلسطينية نادرة شلهوب كيفوركيان (أستاذة مشاركة في الجامعة العبرية في القدس) والأنثروبولوجية الفلسطينية سهاد ظاهر ناشف تحت عنوان «حياتية الموت والميت في المجتمع الفلسطيني» المنشورة في كتاب «تهميش المجتمعات العربية: كبحاً وإطلاقاً» الصادر عن تجمع الباحثات اللبنانيات بالتعاون مع دار جداول.
في هذه الدراسة، ترى كلا الباحثتين أن جسد الميت الفلسطيني مثله كمثل الجسد الحي من ناحية كونه جزءاً من حقل سياسي واجتماعي، وأن جسد الميت هو بمثابة سطح يجري عليه نحت الرموز الاجتماعية وإعادة كتابة القيم الاجتماعية. وبالعودة إلى ملاحظة اغامبين السابقة حول دور السلطات في إعادة تشكيل واختراق جسد الحي أو الميت تحت غطاء ومظلة الطب أو القانون، ترى الباحثتان أن ما نجده في السياق الفلسطيني، هو أن النظام الإسرائيلي يتبع ويكرس سيادته الاستعمارية على الأرض عبر ممارسة ذلك على كل جسد فلسطيني يعيش على أرضه، من خلال التحكم بمكان وزمان عمله، وتلقيه العلاج، وحتى شعوره بالأمان داخل بيته. كما أن المحاولات اليومية لنحت القوة على الجسد الفلسطيني تمتد إلى جسد الميت بواسطة آليات السيطرة المباشرة لنظام العسكرة الإسرائيلية. فعلى سبيل المثال تعد شهادة الوفاة التي يصدرها طبيب العائلة الفلسطيني غير كافية، ولذلك على عائلة الفقيد أن تأتي بشهادة وفاة أخرى من طبيب يحمل رخصة إسرائيلية ومقابل مبلغ من المال. إذ يُفحص الجسد بأيدي طبيب أو جندي إسرائيلي، مما يساهم في إعادة صياغة جسد الميت من جديد وإعادة نحت الأداة الاستعمارية على جسده. من هنا يغدو التحكم بجسد الأحياء والأموات وسيلة للقول إن الإسرائيلي هو السيد على هذه الأرض، بينما يحاول الفلسطيني مقاومة هذه المقولة بعمل وطني يحقق حلمه في التحرر وحلم الميت في العودة الى مدينته (حق العودة) عبر التفنن في طرق إعادة الميت (كما سنرى في حالة القدس) إلى المدينة التي عاش فيها أهله والتي تعيش في الغالب تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. ولتوضيح طبيعة هذا الصراع حول جسد الميت الفلسطيني وأشكال المقاومة التي يخلقها هذا الجسد لدى الأجساد الحية، تجري الباحثتان دراسة إثنوغرافية وتحليلا عميقا لبعض القصص التي جمعتاها ميدانياً، والتي تتعلق بقصص وظروف دفن بعض الأجساد الفلسطينية داخل مدينة القدس وضواحيها، وكيفية تشكل حياة الميت وأقربائه من لحظة إعلان الموت، حتى الوصول إلى المثوى الأخير.
حكايات أهل الموت
أم أحمد، فلسطينية توفيت والدتها في القدس بدون أن تستطيع الوصول لتوديعها، بسبب عدم امتلاكها تصريح الدخول إلى القدس. ورغم وقوفها أمام الجنود لساعات، وتوسلها لأكثر من مرة السماح لها بحضور جنازة والدتها، إلا أن المستعمر رفض مشاركة البنت في عزاء والدتها، وهو ما يشير إلى الكيفية التي يعمل عليها السياق الاستعماري في تسييس الموت والجسد واختراق القوة الاستعمارية بمؤسساتها، ومحاولة إقصاء وتهميش لهذا الجسد ولمن يريد وداعه. بيد أن حالات التهميش هذا بحسب الباحثتين لا تمر بدون فعل مقاومة من قبل الفلسطينيين، الأمر الذي تعكسه قصة العم جميل والصراع في سبيل العودة بجثمانه إلى بيته في القدس، حيث تكشف الأساليب التي تعتمدها العائلة لإعادة الجثة إلى منزلها عن بعد جديد لدى الفلسطيني، رغم كل السياسات الإسرائيلية، يتمثل هذا البعد بالإصرار الرمزي على حق العودة من خلال إعادة الجثة إلى منزلها.
من جانب آخر تذكر نهاد (زوجة لسجين فلسطيني) كيف أن زوجها عانى كثيراً في السجن وكان يحدوه الأمل في أن يطلق سراحه قبل حلول أجله. غير أن ما كان يقلقه في حال الخروج هي الحرارة التي ستكون في البيت. وأمام هذا القلق كانت نهاد تعده بشراء مكيف صغير للبيت، كي يستمتع بفترات من الاسترخاء في غرفته داخل المنزل، ولذلك عندما توفي زوجها في السجن، قامت نهاد بغسله وتكفينه، ثم أخبرت الجميع برغبة زوجها السابقة في الاستمتاع بغرفة مكيفة، ما دفع البعض إلى حمله وأخذه الى غرفة يتواجد فيها مكيف، كي يستمتع جسده بالبرودة كما كان يحلم بذلك. تقول نهاد حينها «لقد كان سعيدا، حتى أنني أحسست بيده تشد على يدي ليعبر لي عن امتنانه، فلقد أتى كل الأقرباء والأصدقاء لرؤيته في هذه الغرفة وكأنه حي وحر».
وبناء على حديث ووصف نهاد السابق، يتجلى لنا – بحسب الدراسة – أن السجان يتعامل مع الفلسطينيين كغرض معطى لسيطرته، وتعامله مع الموت كنهاية للفلسطينيين، بينما في المقابل نجد أن الفلسطيني تعامل مع الموت كبداية حياة الميت كما يرغبها أن تكون. ومن ناحية العائلة، كرس حدث الموت هوية الميت وفلسطينيته من خلال مراعاة رغباته والتعامل مع جسد الميت وأمنياته كذات لا غرض هامد لا مشاعر له ولا أحاسيس. ولذلك يحرر حدث الموت الفلسطيني من أدوات القمع الإسرائيلية كون العائلة استطاعت وبذلت كل ما في وسعها لتحقيق رغبات الميت، أي أن الموت رغم فداحته أحيا القدرة على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. كما أن قصة نهاد وغيرها من القصص المشابهة تعبر جلياً عن سماع المجتمع والعائلة لنداء الميت ولصوت جسده. فرؤية الابتسامة على وجه زوجها وشعورها بامتنانه لما حققته له من أمنيات ما هو إلا سماع صوت من لا صوت له. ذلك أن تحقيق رغبات الميت هي وسيلة لإسماع صوته. وبذلك فإن نهاد أسمعت صوت زوجها الأسير، أو بالأحرى أسمعت صوت المجتمع الفلسطيني بأكمله من خلال جسد الميت.
في جانب آخر، تسلط الدراسة الضوء كذلك على شكل آخر من أشكال المقاومة لطقوس الموت الاستعمارية في فلسطين، حيث يقوم الاحتلال الإسرائيلي في سياق رغبته بتحقيق سيطرة على جسد الفلسطينيين الأحياء والأموات، يقوم الاحتلال بالطلب من الأهالي بدفن موتاهم في ساعات الليل المتأخرة، كتعبير عن كيفية تشكيل قوى الاحتلال لزمن وفضاء الميت. فالليل والظلام يغيبان الميت ويجعلانه غير مرئي، بينما وجود الناس والضوء يجعلان رحلته إلى مثواه الأخير مرئية وملموسة ومسموعة، وهو ما يكثف التعبير عن المقاومة، إذ يعبر طلب الدفن ليلاً عن رغبة الاحتلال بإبعاد أكبر عدد من المشاركين في الجنازة، وبالتالي تهميش الميت. في المقابل، يعبر إصرار العائلة على الدفن نهاراً عن الرغبة الشديدة بالوحدة الفلسطينية وبلم شمل وشتات الفلسطينيين ليجتمعوا في جنازته.
جسد الميت وكتابة التاريخ الحي
من خلال حكايات الموت التي عرضتها الباحثتان في دراستهما، والتي أشرنا إلى بعضها. تمكنت الباحثتان من رؤية الموت والميت كفاعلين أساسيين في سياق المجتمع الفلسطيني في القدس. فالميت على الرغم من عدم حركته يحرك ما حوله من مشاعر وأحاسيس وذكريات تاريخية تعاد صياغتها أثناء حدث الموت. وبهذا فإن جسد الميت الفلسطيني له دور فعال في تشكيل البنية الاجتماعية والسياسية من حوله. كما أنه في سياق الموت في القدس يشكل جسد الميت -بحسب الدراسة – نقطة التقاء القوى المختلفة في المجتمع الفلسطيني، مؤسسة العائلة والمؤسسة الدينية والمؤسسة الاستعمارية، وهذا اللقاء يجري داخل جغرافيا وتاريخ واقتصاد الحياة والموت. فالفلسطيني يشكل الجسد بخطاب ديني ـ وطني ـ اجتماعي، والإسرائيلي يشكله كخطاب استعماري ـ سياسي.
كما أننا نكتشف من خلال الحكايات المختلفة، أن للإناث دورا مهما بل وأساسيا في تشكيل حياتية جسد الميت. فهناك من اهتم مثل نهاد بتحقيق رغبات وأحلام الأزواج والأمهات، وهذا حسب الباحثتين، لا يلغي دور الرجال إلا أنه يثير الجدل حول قضية موت الرجل كحدث يحيي دور الأنثى.
عن القدس العربي