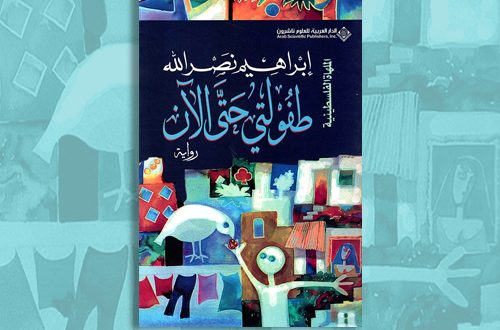- 4 تموز 2022
- ثقافيات
بقلم : محمود شقير
رواية إبراهيم نصر الله الجديدة "طفولتي حتى الآن" هي ذروة أعماله الروائية الجميلة المتميزة.
وهي التي أدرجها إبراهيم في سلسلة روايات "الملهاة الفلسطينية"، لما فيها من تداخل بين الوطني والاجتماعي، وبين الشخصي والعام على امتداد النصف الثاني من القرن العشرين وما بعده وصولًا إلى التذكير بجائحة كورونا التي ما زلنا نعاني منها حتى الآن، وهي تمثل من هذ الزاوية نضجًا فنيًّا وفكريًّا، وتتبلور فيها مهارات إبراهيم نصر الله بعد أكثر من عشرين رواية، لتأتينا بكامل زخمها الذي ينم عن قدرات مؤلفها الذي اتخذ من سيرته الشخصية مادة شائقة لكتابة رواية، ولم يتوقف عند حدود السيرة ومعطياتها وحسب، بل إنه أطلق لمخيلته العنان لكي يمزج ما هو واقعي فعلي معيش بما هو متخيل، إلى الدرجة التي تجعل المتلقي يشعر بأن هذا المتخيل، بسبب من براعة تجسيده، ما هو إلا الواقعي، وأن الواقعي، بسبب من عمق تجسيده في النص، ما هو إلا المتخيل الذي نلمسه في الروايات الكبرى الناضجة.
وحين يتناول إبراهيم نصر الله طفولته في الرواية فإنه يضعنا أمام إحساس متجدد بالحياة، حيث ينشىء له مطارًا في المخيم قريبًا من البيت يسافر منه مع صديقته نور إلى باريس وغيرها من بلدان العالم، وبذلك فإن هذا التسامي على واقع المخيم ينقلنا إلى حيز التحدي والرغبة الجارفة في الحياة.
كذلك، فإننا نلمس من خلال أحداث الرواية ومتابعة شخصياتها الغنية المتنوعة أن هذه السمة، سمة التحدي وحب الحياة، ليست وقفًا على الطفل إبراهيم وحده، بل إن أغلب شخوص الرواية، مكرسون لحب الحياة وللرغبة في تعزيز القيم الإيجابية فيها، قيم الحب والتضحية والإيثار والجمال.
وفي حين ترصد الرواية واقع المخيم من خلال حياة الناس فيه، وهمومهم وآمالهم وتطلعاتهم فإنها لا تكتفي بذلك، بل تأخذنا بين الحين والآخر عبر ذاكرة الشخوص إلى المكان الأول الأصلي الذي شرد منه هؤلاء الناس: فلسطين.
من هنا يمكن أن تكون هذه الرواية تعبيرًا عن زخم "الملهاة الفلسطينية"، ومنطقها الذي يحاكم الواقع واشتراطاته، ويتابع الشخوص وهم يحاولون فك طلاسم هذا الواقع وتحدي قيوده في سبيل المحافظة على الكرامة واحترام الشخصية الإنسانية وتعزيز تطلعاتها المشروعة في الحياة.
بسرد مرهف جذاب لا يخلو من فكاهة عذبة استمرت على امتداد صفحات الرواية، وبلغة جميلة تخالطها بعض مفردات من اللهجة العامية الفلسطينية يتحدث إبراهيم نصر الله عن طفولته التي تحضر فيها الأم عايشة بشكل فعّال.
تحضر أيضًا الطفلة نور، صديقة إبراهيم الحريصة على تفوقه في المدرسة مثل حرص أمه التي تبوأت منصب "وزيرة التربية والتعليم" (ووزارة المالية فيما بعد) من جراء متابعتها لأبنائها ولضرورة إنجازهم لواجباتهم المدرسية، ولا تكتفي "الوزيرة" بذلك، بل إنها في بعض أوقاتها تروي للأبناء عن العذابات التي عاشتها مع أهلها أثناء الهجرة القسرية من الوطن. هنا نحن أمام ذاكرة تسرد المآسى كي لا تضيع، وكي يظل الوطن حاضرًا في أذهان الجيل الجديد الذي لم يعش مرارة التشرد والعطش والجوع والحرمان.
ولن تكتمل طفولة إبراهيم إلا بحضور حنّون وأخواته الثلاث ومن أبرزهن فدوى، ووالده المريض بالربو بسبب غبار التبغ، وجدّه عليّ وجدّته خضرة، وخالته زينب وخاله أحمد صاحب الخط الجميل المحب للغناء، وخاله محمود الشاعر الذي سوف يسافر إلى الكويت ثم إلى السويد، وهو الذي أثّر في الطفل إبراهيم وزوَّده بمعلومات عن الشعر والشعراء، وخصوصًا عن وجود شاعر اسمه إبراهيم طوقان وله أخت شاعرة اسمها فدوى طوقان ( ما جعل إبراهيم يتمنى أن تلد أمه الحامل طفلة تسميها فدوى، وقد تحقق ذلك بالفعل) وكذلك عمته؛ وزيرة الطاقة ووزيرة الدفاع، التي أحبت ثم تزوجت ذلك الفلسطيني الغامض الذي كان يتحدث المصرية، ما جعل الناس في مخيم الوحدات يطلقون عليه لقب: "المصري"، وهو الذي سيلتحق بالفدائيين وسيكون من بين شهداء معركة الكرامة التي وقعت بتاريخ 21 آذار 1968.
ثمة أيضًا من أصدقاء الطفولة: قاسم وفؤاد ونبيل، الذين انشغل السارد باستحضارهم بين الحين والآخر مضفيًا على نصه الروائي مزيدًا من الغنى والجمال، علاوة على حضور الشأن العام ممثلًا باستحضار الذكريات عن الوطن وعن المآسي التي وقعت أثناء كارثة 1948، ثم التوقف عند خيبة الأمل التي أعقبت هزيمة حزيران1967، وما سبقها وما وقع بعدها، وخصوصًا انطلاق العمل الفدائي ردًّا على الهزيمة، ومشاركة السارد وأصدقائه في المظاهرات وفي الاحتفالات التي كانت تقيمها التنظيمات الفلسطينية في مخيم الوحدات، والاحتفاء بصديقته نور التي التحقت بالعمل الفدائي، ثم أصبحت طالبة طب في القاهرة بعد تجربتها القاسية في معارك أيلول.
وستفاجئنا الأم عايشة التي حرصت على متابعة أبنائها وبناتها في مدارسهم، بالتحاقها بصفوف محو الأمية، ما يضعنا أمام نموذج "الأم" التي تتبوأ مكانة بارزة في السرد الروائي مع نماذج أخرى لا تقل حيوية وفاعلية؛ من بينها شخصية الجد "عليّ" الذي كان يعبر عن أحزانه وعن لوعات الحب المختزنة في قلبه بالشعر العامي المرهف المثير.
لا يسير السرد في هذه الرواية وفقًا للزمن الخطي المألوف.
فثمة انتقال من الحاضر إلى الماضي، ومن الماضي إلى الحاضر، وثمة رسائل تكتبها نور بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل الطفولة، تتضمن تقييمًا لما تم إنهاؤه من الرواية، وتمهيدًا لما لم تقرأه نور بعد، وهي التي خصّها ابراهيم بقراءة كل جزء ينجزه من الرواية قبل إتمامها، ما يضفي على السرد حيوية، وما يجعل إيقاع الرواية بعيدًا من الرتابة. ومع تتابع طفولات السارد الذي هو بطل الرواية وصاحب السيرة، تتنوع الرؤى والأفكار، وتغتني المشاعر والأحاسيس، و تتشابك علاقات الصداقة والحب، ونتعرف إلى مصائر أصدقاء السارد، وتتسع عوالمه وتنفتح أمامه الآفاق، وخصوصًا حين تبرز مواهبه وقدراته في كتابة الشعر والرواية والمسرح، وفي الرسم والعزف على العود وكتابة الأغاني الوطنية وتلحينها، ويصبح من جراء ذلك صاحب شهرة وكاريزما تجعل حياته أكثر غنى، وتجعله في حالة اشتباك خصب مع محيطه ومع الحياة، ونلمس مقدار تأثير غسان كنفاني عليه حين قرأ أدبه الملتزم وهو يعمل مدرسًا في الصحراء البعيدة، ونلمس أيضًا مقدار احتفاء إبراهيم المستحق بشقيقه محمد نصر الله، الفنان التشكيلي، صاحب الأسلوب الفني المدهش، الذي يدل أسلوبه عليه حتى لو لم يكتب اسمه على لوحاته.
نلمس كذلك كيف ظلت نور منذ الطفولة، وبعد أن أصبحت طبيبة متمرسة وهي تحمل أجمل المشاعر تجاه السارد منذ كانا طفلين في المخيم وإلى آخر الصفحات في الرواية، وكيف أنها وهي الحبيبة باركت حبّ السارد لتلك الفتاة الجميلة الجريئة هالة التي ساقتها الصدف إلى فضاء حياته منذ أن كان طالبًا في معهد المعلمين، ثم شجعته على الزواج بها، في حالة فريدة من الإيثار والتجرّد والإخلاص، وبذلك، وأمام هذه المشاعر الإنسانية الراقية، والتفاصيل الحميمة الكثيرة، تكون رواية إبراهيم نصر الله قد وصلت ذروتها مع طفولته السابعة التي اشتملت على كل ما أنجزه من دواوين شعرية وروايات ومؤلفات أخرى، ونكون أمام اكتمال السرد الممتع المرهف الطالع من رحم التجربة، ومن عمق التأملات في التضحية من أجل الوطن حدّ الاستشهاد، وفي الصداقة والحب والحزن والفرح والمرض والموت، واستعادة المشاهد وما تثيره من انفعالات كما لو أنها تحدث أمام أعيننا الآن.
بقي أن أذكر أنني كتبت مقالة محدودة الكلمات عن "المخيم في الرواية الفلسطينية" باقتراح من إحدى الزميلات الكاتبات لإحدى الصحف.
بدأتُها بالروايات التي رصدت الصدمة الأولى للنكبة ووصف مؤلّفوها تشكّل المخيم في بداياته الأولى، ثم أتبعتُها بذكر أبرز الروايات التي تجاوزت الصدمة الأولى وانتبهت للروح الجديدة التي سادت في المخيمات، وتمثَّلتْ في رواية "أم سعد" لغسان كنفاني، التي أشاد فيها بانطلاق المقاومة، وفي "طفولتي حتى الآن" أحدث رواية لإبراهيم نصر الله التي أشاد فيها بالروح الجديدة الرافضة لنتائج الهزيمة، والتي ترى في المخيم مكانًا مؤقتًا تحيا فيه نماذج بشرية محبّة للحياة، تحفزها على ذلك ذاكرة عابقة بحب مكانها الأول في فلسطين، غير منقطعة في الوقت ذاته عن التفاعل مع التطورات السياسية في مكان اللجوء. أو كما جاء في الرواية ذاتها:"ليس لدينا خيار سوى أن نصعد عتبات المستقبل، مهما كانت مهشّمة، بل حتى لو لم نستطع رؤيتها!".
تحية للروائي الكبير إبراهيم نصر الله ولإبداعه الروائي المتميز.