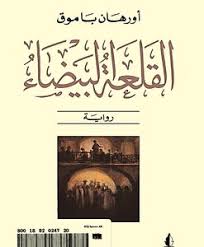- 16 أيلول 2025
- ثقافيات
بقلم : د. علي العزّي *
قراءتي التحليلية في رواية القلعة البيضاء للكاتب التركي أورهان باموق، الحائز على جائزة نوبل للآداب. هذه المداخلة ألقيتُها أثناء مناقشة الرواية في الجلسة التي عقدها ديوان الأدب في 4 أيلول 2025.
《رواية القلعة البيضاء، للأديب التركي المرموق "أورهان باموق"، في شكلها ومضمونها، تأتي ضمن سلسلة الروايات التي يجب قراءتها، لا بالعيون فقط، بل بالعقول أيضًا. وأقصد بذلك أهميّة موضوعها، الذي يضيء على مسألة إعادة بناء الحضارة، من خلال تحفيز العقل بالنشاط العلمي والأخلاقي، والعمل على تحديث الثقافة الوطنية والإنسانية.
إن الإضاءة على مكامن القوَّة والضعف التي عاشها أبطال هذه الرواية اجتماعيًا وثقافيًا ومعرفيًّا، كفيلة بأن تضعنا في مقاربةٍ شاملة مع الواقع الحالي لشرقنا الحزين وعالمنا العربي المتخبِّط. ومن خلال هذه الإضاءة ربما نستطيع تحديد ما نريده لبلادنا في المستقبل القريب والبعيد؛ خاصّةً أن الزمن اليوم أصبح يسير بشكلٍ متسارع، حيث لا مكان بعدُ لترف الوقت والانتظار، ولا للمكوث في حال الارتباك والنقص القائمين اليوم.
للعلم، إن هذه الرواية التي تُرجِمت إلى اللغة العربية في مئةٍ واثنتين وخمسين صفحة (152 ص)، قصيرةٌ مقارنةً بروايات أخرى، لكنّها في الوقت نفسه مكثّفة، بحرفيّة كاتبٍ استحقّ بسببها جائزة نوبل للآداب.
هنا، كان التكثيف فعلَ مهارةٍ فكرية حاذقة، أدّت دورَها الأدبي والفكري والثقافي والإنساني، لتجعلَ من يقرأها يُفكّر ألف مرّةٍ بعنصريته وتعصّبه القومي أو الديني، إن كان يحمل هذه القناعات، من أجل أن يصبح إنسانيًا قبل أيّ شيء آخر، وليعرف ويقتنع أنّ الحياة تفاعلٌ وتعاون إلى حدّ الاندماج مع الإنسان الآخر، بغضّ النظر عن انتمائه الإثني أو الديني أو الطائفي. يصلح هذا القول أيضًا على الفرد وعلى المجتمع، كما على البلد، وحتى على الحضارات المختلفة القائمة اليوم في هذا العالم.
نستطيع أن نلاحظ بعد قراءة الرواية أنّها متعدّدة الأبعاد، تكشف صراع الهوية والذات مع ذات الإنسان نفسه. فالكاتب هنا يطرح الفوارق بين الشرق والغرب، ويجمع فيها بين التأمّل التاريخي والفلسفي واللعب الميتاسردي.
صدرت هذه الرواية سنة 1985، وتجري أحداثها في القرن السابع عشر؛ علمًا أنّه لم تُحدَّد بدقّة السنةُ التي جرت فيها الأحداث. وهذا دليل يؤكّد أنّ فكرة الرواية كمادّة تاريخيّة وجدها أحدُهم في أرشيف قائمقامية غُبزة، بلدة تقع شمالَ غربِ تركيا، هي محضُ خيال، لكنها كانت مطلوبة لغرض السرد الأدبي والخيالي ليس إلّا.
تبدو الرواية للوهلة الأولى حكايةَ أسيرٍ إيطالي شاب، عمره 23 سنة، كان يُبحر من مدينة البندقيّة إلى مدينة ناپولي، فيقع في قبضة العثمانيّين، ثم يُسلَّمُ إلى رجلٍ تركيّ: باحثٍ وعالمٍ متعدّد المواهب والرغبات، يكبره بخمس سنوات تقريبًا، لكنّه ـ وهذا الأهم ـ يشبهه في الشكل والوجه حدَّ التطابق، كأنّهما توأمان، لكنّهما مختلفان بالطبع والمبادئ والقيم.
فالإيطالي عقلاني، متعلّم وواثق، يميل إلى التفكير العلمي، لكنّه لاحقًا يتعرّى تدريجيًا بسبب ظروف الأسر، حيث تتصدّع ذاكرته وحدود ذاته كلّما تقارب مع صورته المعكوسة في المرآة، أو في وجه شبيهه.
أمّا "الأستاذ" التركي، فهو فضولي، ذكي وشغوف بالمعرفة، يتأرجح بين الرغبة في العلم والهيبة والسلطة؛ لكنّه في الوقت نفسه يبحث عن سرِّ التقدّم الغربي، ويُرهقه سؤال كبير: لماذا نحن هنا متخلِّفون، وهم هناك متقدِّمون؟
مع الوقت، ورغم أنّ الإيطالي أصبح فعليًا عبدًا عند شبيهه التركي، تنشأ بينهما علاقةٌ معقّدة من التبادل المعرفي والنفسي. فالإيطالي يعلّم الأستاذَ التركي العلومَ والفلكَ والهندسةَ والطب، والأستاذ يعلّمه دهاليزَ السلطة في البلاط العثماني من أجل النجاة، لكنه مع ذلك يحاول السيطرة عليه نفسيًا.
ذروة الرواية تأتي عند تكليفهما من السلطان العثماني بناءَ آلةٍ حربيةٍ ضخمة، لزوم مهاجمته للعدو المحتمل. لكن الآلة تفشل في النهاية؛ ربما كإشارةٍ إلى ضعف المعرفة، التي يتطلّب امتلاكها زمنًا طويلًا كي تصبح كافية للنصر على الخصوم أو الأعداء.
وهنا نجد في طرح فكرة الآلة عند باموق محاولةً لحسم مسألة التخلّف بضربة تقنية واحدة؛ لكنّ الآلة تنهار في الوحل، لأن مسألة التخلّف الحضاري تحتاج إلى معالجات طويلة وزمنٍ أطول.
في هذه العلاقة بين الرجلين، وخلال تعاونهما واستفادتهما من بعضهما، ثم فشلهما لاحقًا في صناعة الآلة الضخمة، تبدأ أسئلة باموق عن الهوية وتلاقُح الحضارات بالظهور، وهي أسئلة جوهرية وفلسفية، تحتاج فعلًا إلى النقاش الدائم والطرح المستمر.
ومن بين الأسئلة الكثيرة، نختار الأهم، وفيها أيضًا رموز عديدة. علمًا أنّ هذه الأسئلة طرحها باموق في ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدًا سنة 1985، حيث كان أغلبنا يعلم الفوارق العلمية بين الشرق والغرب، وأن التقدّم منذ ذلك الحين أصبح واضحًا لصالح الغرب. لكن مع ذلك، هناك في الشرق ما يمكن للغرب أن يتعلّمه على المستوى الروحاني، رغم أنّ هذه المسألة تحتاج اليوم إلى تدقيق في ذروة الأزمات الاجتماعية والثقافية وحتى الأخلاقية في الشرق، حيث يتحكّم رجال الدين في عقول الناس ويؤثّرون بذلك في البيئات الاجتماعية، بما يترك أثرًا بارزًا في مسألة التقدّم الحضاري.
هناك فعلًا أسئلة يجب التوقّف عندها:
أولًا: في صراع الهوية وفهم كلٍّ منّا لنفسه وللآخر: من أنا؟ وهل أنا ـ أنا؟ من هو؟ وهل هو ـ هو؟ أم أنّ لنا فيه ما لنا؟ وهل يكفي، إذا نظرنا في المرآة، أن نتعرّف إلى أنفسنا؟ وهل من الصحيح أن نعرف أنفسنا حسب نظرة الآخرين إلينا؟ كيف يمكن أن يتحوّل كلٌّ واحدٍ منهما إلى الآخر؟ ومن هو فعلًا في هذه الرواية السيّد، ومن هو التابع؟
ثانيًا: هل فكرة التعلّم عن طريق النقل كافية للتقدّم، وبالتالي للاقتراب مما وصل إليه الآخرون أو للتشابه معهم؟ هنا نستدلّ على أنّ الفرق بين المعلّم والتلميذ يبقى قائمًا، لأن العلاقة معقّدة وجدلية بين من يملك المعرفة ومن يتعلّمها بالحفظ المجرّد.
ثالثًا: المقارنة بين الغرب والشرق. هنا يجدر القول إن هذه المسألة كانت قويّة في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كتب باموق هذه الرواية؛ وقتها أراد الكاتب أن يؤكّد أنّ العقل الغربي عقلٌ تجريبي ومرن، يتغيّر ويتطوّر مع تقدّمه في العلم، وبالتالي مع تطوّر وسائل الإنتاج، بينما العقل الشرقي عقل متلقٍّ وميتافيزيقي جامد.
إن مجمل الأسئلة المطروحة هنا أثناء القراءة، والمفترضة بعدها لفهم القصد والمعنى والهدف من الرواية، تؤكّد أنّ تركيا وشعبها غارقون في دوّامة الأسئلة عن الهوية، بحكم التداخل الجغرافي لتركيا بين آسيا وأوروبا، بما فيه من تفاعل أنثروبولوجي وسيكولوجي.
إن الرموز والدلالات التي أوردها الكاتب في الرواية، كالتشابه بين الإيطالي والتركي، تبدو كأنها تقول إنّ الإنسان في حضارتي الشرق والغرب واحد، وأنهما ليسا نقيضين تامّين لبعضهما، بل يمكن أن يكمّلا بعضهما البعض، بتبادل المعرفة والتساوي إذا كانت الظروف الاجتماعية متكافئة بقيمها الإنسانية والعلمية.
أمّا اسم الرواية ـ القلعة البيضاء ـ فيُرمز إليه هنا كأنّه ورقة بيضاء، تعني النقاء والجهوزية، وبأنها تتقبّل أن يُكتَب عليها ما وصل إليه الآخرون من معرفة وتقدّم وحضارة، كي ترتقي مع الآخرين وتستفيد من التقدّم الهائل، تمامًا كما فعل الأستاذ التركي، البطل الثاني في الرواية.
︎ الخاتمة:
لا يجب أن تُصنَّف هذه الرواية في خانة الأدب التاريخي أو الشرقي، إنما أراها تمثّل مغامرة فكرية جامعة وإنسانية حداثوية ميتاسردية.
أعتقد جازمًا أن "أورهان باموق" يريد أن يقول إنّ الأسير الإيطالي والأستاذ التركي شخصيّتان متقابلتان بقدر ما هما وجهان لمرآة واحدة، وأن كلّ واحدٍ منهما يمكن أن يرى نفسه من خلال الآخر، شرط أن تتوافر الرغبة ويتوافر السلام الروحي. كما يريد باموق أن يبرهن للقرّاء، بعد أن فهم حصيلة الصراع الحضاري الذي ما يزال قائمًا، أن الإنسان الغربي لا بد أن يجد في الرجل الشرقي، رغم تقدّمه العلمي، ما يمكن أن يضيف إلى نفسه ما هو وجداني وجميل. وأنّ السلطة والنفوذ عند التركي، والشرقي عمومًا، ليستا ضمانة أكيدة يمكن من خلالهما بسط كلّ النفوذ على الآخر
علمًا، وهذا رأي خاص أردت إضافته هنا، أنّ الغربيين لا يمتلكون العلم والتقدّم الحضاري فحسب، بل قد استفادوا فعلًا من حضارة الشرق القديمة، ما جعلهم يتميّزون أيضًا بالأخلاق العالية والروحانية السامية.
وأخيرًا، أرى أنّ القوّة لا يمكن أن نحصرها بالعلم والتكنولوجيا فقط، كما لا يمكن أن تكون بالسلاح وحده.
القوّة الفعلية يمكن أن تكون بالعلم والمعرفة والحضارة المتقدّمة، محميةً بالسلاح. فالسلاح والنفوذ لم يحميا السلطنة العثمانية من الاندثار، وأنّ السلطة ليست قدرًا ثابتًا ولا دائمًا. وهذا ما رأيناه في الرواية عندما تحوّل الأستاذ العثماني من سيّد في فترة ما إلى تابع في فترة أخرى.
* كاتب وناقد من لبنان