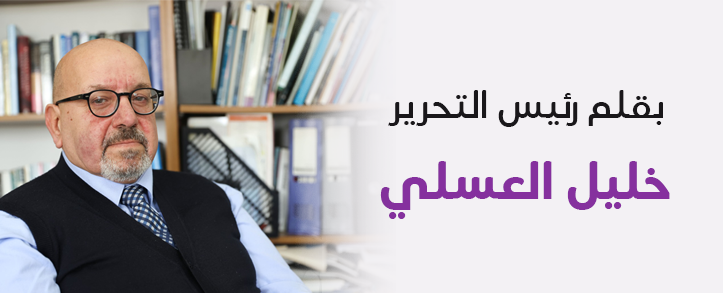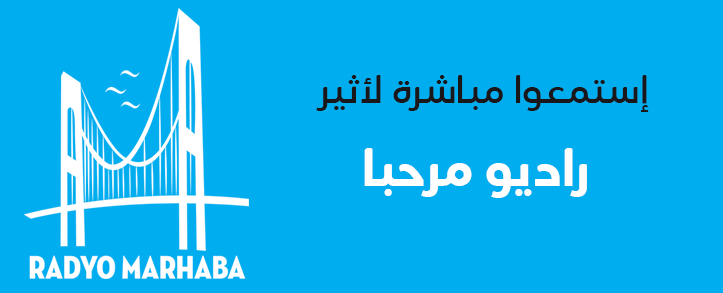- 1 تشرين الثاني 2025
- ثقافيات
بقلم : ا . د. زيدان عبد الكافي كفافي *
يفتتح بعد أيام قليلة "المتحف المصري الكبير" والذي يضم كنوزاً أثرية مصريةتعكس حضارة مصر عبر العصور القديمة. وأقيم بناء المتحف على مساحة قدرها 117 فدان (تبلغ مساحة الفدان الواحد حوالي 4200 متراً مربعاً) في منطقة قريبة من أهرامات الجيزة. ويضم البناء قاعات عرض تحوي أكثر من 100.000 ألف قطعة أثرية تعود بتاريخها للعصور الفرعونية القديمة، واليونانية، والرومانية، إضافة لمباني خدمات تجارية وترفيهية ومركز ترميم القطع الأثرية ، وحديقة متحفية. صُمم المتحف ليتسع لحوالي 5 ملايين زائراً سنوياً. وقد تم تمويل بنائه من عدة جهات أجنبية أهمها "جايكا اليابانية" وتم تصميم البناء وتنفيذ العرض من قبل شركات أجنبية ، منها الإنجليزية “Atelier Bruckner”.
يشعر الإنسان بالزهو والافتخار بمثل هذا الانجاز العربي العالمي، و يتقدم بالتهنئة والتبريك لمصر وللعرب وللعالم بهذا الإنجاز العظيم الذي يمثل مستودعاً أميناً لذاكرة مصر في العصور القديمة. شعرت نفسي مشدوداً نحو هذه الذاكرة الجمعية لمصر "أم الدنيا"، والتي تقدم تاريخها مرئياً لكل من يريد مشاهدته، فالعين هي التي تقرأ هذه الأيام. وأنا كآثاري أقدّر أن العدد الكبير من القطع الأثرية المعروضة في المتحف تتطلب من الزائر أن يمكث مدة طويلة وهو يتفحص ويقرأ تاريخ كل منها، فليس جمال القطعة هو الأساس، وإنما قصة القطعة الأثرية من بداية تشكيلها حتى وصولها للشكل النهائي، وكذلك الفكرة التي كانت في رأس من عملها، وكيفية تنفيذها. إن القطعة الأثرية، أي قطعة كانت، هي مرآة لزمانها ومكانها.
الهدف من عرض الآثار هو تقديم سردية الأرض والإنسان، وتبين مدى تطور الفكر الإنساني من خلال سيطرته وتفاعله مع البيئة/ البيئات التي عاش فيها. نعم، استطاع الإنسان المصرية القديم أن يسيطر على بيئته، بل وأن يقدم ما وصل إليه ذهنه من فكر وحضارة إلى المجتمعات الأخرى التي تواصل أو اتصل بها. فتجد الآثار المصرية القديمة تنتشر فوق بلدان كثيرة، خاصة في منطقة حوض البحر المتوسط، وهذا دليل على فضل مصر على العالم في تقديمه المعرفة لهذه البلاد. وإذا كان الأمر هكذا، فإنني أجد نفسي مجبراً على تقديم وقفات تاريخية وفكرية مصرية قديمة قدّمها المصريون القدماء لأنفسهم قبل أن يقدموها لغيرهم من الناس، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من عظمة، و ألخصها بما يلي:
1. الوحدة الوطنية:
ينسب إلى الملك "مينا/ نعرمر حوالي 3273 – 2987 قبل الميلاد" أنه موحد الوجهين القبلي والبحري ومؤسس الأسرة المصرية الأولى. ويرى بعض المؤرخين أنه خلف الملك " العقرب" من عصر ما قبل الأسرات في الحكم، بينما يرى آخرون أن الملك نعرمر ومينا هما نفس الشخص.
ويظهر أن المصريين القدماء قد احتفلوا بالوحدة الوطنية، لأنهم رأوا أن في الوحدة قوة وأنها التي تمكنهم من بناء وطنهم، وبلوغ مآربهم. وينعكس هذا الأمر في المناظر الموجودة على لوحة نعرمر التي تخلد هذه الوحدة. ومن المعلوم أن لوحة "نعرمر" قد اكتشفت عام 1898م على يد "جيمس إدوارد كويبل" في مدينة "هيراكونبوليس". ومما يذكر لهذا الملك أنه بنى مدينة "منف"الواقعة بين الدلتا والصعيد مؤكداً على وحدة بلاده، وشكل أول حكومة مركزية في التاريخ، وعمّ الأمن في البلاد أيام حكمه. إذن كانت وحدة البلاد هي التي وضعت اللبنات الأولى للتقدم الحضاري المصري في العصور اللاحقة.
2. العظمة:
تم ابتداء من زمن الأسرة الرابعة المصرية في عصر الدولة القديمة (حوالي 2600 – 2500 قبل الميلاد) بناء مجمع أهرامات الجيزة، والتي هي واحدة من الأعاجيب العالمية، والتي تضم الهرم الأكبر، وهرم خوفو، وهرم خفرع. وجاء بناء "المتحف المصري الكبير" مجاوراً لها، مكوناً مجمّعاً سياحياً كبيراً.
نعم بناء الأهرامات متميز بضخامته، وأعجوبة عصره، لكن كيف تمكن المصريون من بناء مثل هذا البناء، ألا يدل ذلك على عظمة أهلها وتقدم فكرهم؟ أيضاً، كيف تم تنفيذ هذه الفكرة، أنا أرفض فكرة "العمالة بالسخرة" ، وإن وجدت، فلا بد إلاّ أن يكون هناك مهندسون وفنيون ومهاريون قاموا على بناء مثل هذه الأبنية الضخمة، دُفع لهم الأجر مقابل عملهم. كذلك فإن الأمر يتطلب وجود إمكانيات اقتصادية مادية، فمن أين جاءت هذه الموارد. أنا أزعم أن مصر وحتى قبل تأسيس الأسرات كانت على تواصل مع البلدان المجاورة، فعلى سبيل المثال ربطتها تجارة مع جنوبي بلاد الشام، فهم حصلوا على خامات النحاس من منطقة وادي عربة، وما العثور على قوالب لصب النحاس في مواقع بجنوبي الأردن، مثل موقع "حجيرات الغزلان" و في موقع "المعادي " بمصر بتزامن تاريخي يعود للألف الرابع قبل الميلاد، إلاّ دليل على ما ذهبنا إليه.
3. القوة العسكرية (عصر الإمبراطورية):
تكونت في مصر بعد طرد الهكسوس من منطقة الدلتا المصرية في حوالي 1550 قبل الميلاد، وعلى يد الملك "أحمس الأول" دولة قوية عسكرية أسست لما يعرف باسم "الدولة الحديثة" أو "عصر الامبراطورية" في مصر. وحكمت الأسرات 18 – 20 على هذه الدولة الحديثة، علماً أنهم اختلفوا في أنماط حكمهم وتفكيرهم. مرت هذه الدولة التي استمرت في حكمها على مصر حتى حوالي 1150 قبل الميلاد بين فترات قوة وترهل. وحيث أنني لا أملك الوقت الكافي لكتابة التفصيلات، لكني سأمر في هذه العجالة على بعضٍ منهم، وأبدأ بملك أنا معجب جداً بقوة شخصيته وشجاعته، هو، تحتموس الثالث (حوالي 1490 – 1436 قبل الميلاد).
توفي والدتحتمس الثالث وهو صغير بالعمر، فكانت زوجة أبيه "حتسبسوت" وصية عليه (حوال 1490 -1479 قبل الميلاد)، وكانت هذه الملكة من القوة والعظمة بأنها شيدت المباني الكبيرة، بل أنها أرسلت بعثة تجارية إلى بلاد "البنط" لإحضار الذهب وغيره مما تيسر من المواد الثمينة. وبعد أن بلغ تحتموس الثالث الرشد (حوالي 1479-1436 قبل الميلاد) استلم مقاليد الحكم، واهتم ببناء الجيش، إذ أصبحت قوة مصر العسكرية لا تضاهى في المنطقة. بناء عليه توسع في حكمه وسيطر على بلاد الشام بعد أن جرد عليها 17 حملة عسكرية. وكان الرجل قائداً محنكاً وعارفاً، فقد كان يجلب معه إلى مصر أبناء حكام وأمراء ممالك بلاد الشام، حتى يربوا في البلاط الفرعوني فيصبحوا موالين للحكم في مصر. كما كان يحضر معه جميع أنواع النباتات والحيوانات غير متوفرة في مصر. هذه حكاية تحتموس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة.
أما المثال الثاني على قوة مصر العسكرية في العصور القديمة فهو يخص الملك "رمسيس الثاني حوالي 1290 – 1213 قبل الميلاد"، وهو ثالث ملك من ملوك الأسرة التاسعة عشرة، ويعدُّ أشهرهم، وأطولهم زمناً في الحكم. ومن المعلوم أن هذا الملك قاد عدة حملات على بلاد الشام لاستعادة السيطرة عليها بعد تراجع النفوذ المصري عليها، كما شنّ حملات على بلاد النوبة أيضاً.
تنازع المصريون والحثيون في بلاد الأناضول السيطرة على بلاد الشام في الفترة القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد، خاصة بعد حكم أخناتون على مصر، من هنا أراد المصريون العودة بقوة لهذه البلاد، فكان الصدام حتمياً بين القوتين. وهذا ما حدث بالفعل حيث استمر الصراع العسكري بينهما حتى التقت القوتان في حوالي 1260 قبل الميلاد في معركة قادش، بالقرب من مدينة حمص السورية الحالية. ودارت معركة بين الجيشين استمرت لعدة أيام، لكنها لم تنتهي بهزيمة أحدهما للآخر، فعقدا اتفاقية بين الطرفين المصري بقيادة رمسيس الثاني والحثي بقيادة "حاتوشيل الثالث". فبقيت منطقة شمالي بلاد الشام (شمالي حوض نهر الفرات) تابعة للحثيين، وجنوبيها للحكم المصري. ويمكننا القول أن هذه المعاهدة هي أقدم معاهدة سلام في التاريخ.
بقي المصريون القدماء يسيطرون على بلاد الشام حتى تراجعت القوة العسكرية المصرية القديمة، في تقديري ربما بعد الأسرة الحادية والعشرون. إذ ما زلنا نعثر على آثار مصرية من زمن الأسرة العشرين في مواقع أردنية، كما هو حال خرطوش الملكة/الفرعونية تاوسرت الذي عثر عليه في موقع دير علا/ غور الأردن في الأردن.
4. التقدم الفكري الديني:
تشكّل النظام الديني في مصر القديمة من تعدد في المعتقدات وطقوس كانت جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المصريين في حينه. وقد تمحورت هذه حول علاقة وتفاعل الشخص المصري مع العديد من الآلهة التي اعتقد انها تسيطر على الكون وتسيره. واعتقد المصريون القدماء أن حكامهم امتلكوا قوى إلهية بحكم مناصبهم، إذ أنهم كانوا وسطاء بين الناس والآلهة. لكن ومع مرور الوقت تراجعت وتقدمت أهمية آلهة معينة على الأخرى، فتغيرت علاقة الناس معها حسب أهميتها. وبرزت بعض الآلهة، فكان هناك الإله "رع" إله الشمس، والإله "أمون" إله الخصوبة، والإلهة "إيزيس" إلهة الأمومة.
تغير الأمر مع اعتلاء الملك أمنحوتب الرابع (حوالي 1353 – 1336 قبل الميلاد)الإبن الأصغر للفرعون "أمنحوتب الثالث" أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة، الذي غيّر اسمه إلى "أخناتون" تكريماً للإله "أتون" المتمثل بأشعة قرص الشمس. وتبنى هذا الفرعون عبادة إله واحد، أي "أتون"، ونهى عن عبادة الآلهة المصرية الأخرى، وهذا يمثل أول حالة توحيدية دينية عالمية. وقد رافق هذا التغير الديني إلى نقل العاصمة إلى موقع "تل العمارنة".
لكن هذا الأمر الديني الجديد لم يدم طويلاً إذ قام خلفائه في الحكم "توت عنخ أمون" و "حور محب" بطمس كل ما يتصل بهذه الديانة التوحيدية، وإعادة إحياء عبادة الآلهة القديمة ولو بصورة تدريجية. ويحضرني هنا قبر توت-عنخ-أمون وفخامة وتنوع مقتنياته الأثرية، إن دلت على شيء فإنما تدل على عظمة مصر وأهلها في تلك الحقبة من الزمان.
هذا فيض من غيض حول الحضارة المصرية القديمة، وددت أن انتهز فرصة افتتاح "المتحف المصري الكبير"، لأقدمها هدية لرئيس المجلس الأعلى للآثاريين العرب" الأستاذ الدكتور محمد الكحلاوي، ولجميع المصريين،والعرب، والعالم، لأن الآثار ملك للعالم أجمع ، ومن واجب الجميع المحافظة عليها وتقديمها للناس، علماً أنها تمثل وثائق الجنسية للبلد التي يعثر عليها فيه. عاشت مصر أم الدنيا عربية حرة.
والله من وراء القصد
* -أستاذ شرف – جامعة اليرموك-الأردن ، عضو المجلس الأعلى للمجلس العربي للآثاريين العرب