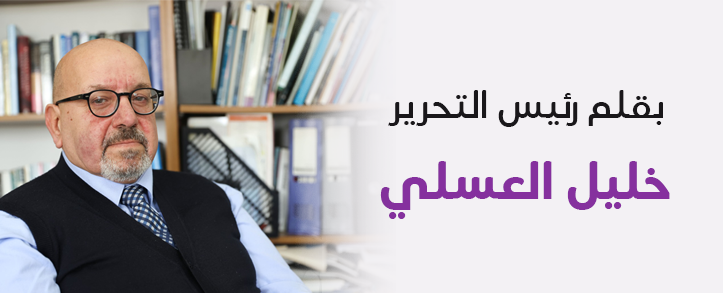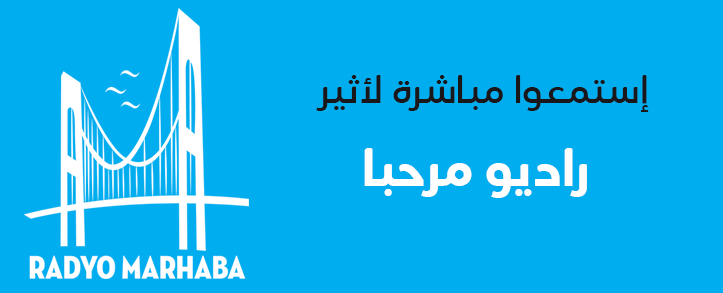- 15 أيلول 2025
- حكايات مقدسية
بقلم : الشيخ الباحث مازن اهرام
العديد من الحكم و الأمثال التي نقولها ونستمع إليها وربما لا نعرف القصص التاريخية المرتبطة بها أو أصلها في مجتمعنا المقدسي أو الأحداث والمناسبات التي قيل بها المثل الشعبي جملة قصيرة بليغة متوارثة عبر الأجيال، سهلة الانتشار وسريعة التداول جاءت تعبيرا عن تجربة محددة وشاع استعمالها بمناسبة وقوع تجارب أو مواقف مماثلة للتجربة الأصلية وهو نتاج لتداخلات التاريخ والثقافة والجغرافيا والأدب والاقتصاد والدين والعادات والتقاليد ويُعدّ المثل الشعبي الفلسطيني ركنًا مهمًّا من أركان التراث الشعبي الفلسطيني؛ لبلاغة تعبيره عن مختلف تجارب المجتمع الفلسطيني التي مر بها عبر العصور والتي تعبر عن ثقافته وطرق عيشه ومختلف المعاملات والأخلاق التي تعارف عليها الناس فيه وبعض هذه التجارب اختفت قصتها أو تفاصيلها، واستمر المثل المعبر عنها في التداول؛ في حين ما زالت قصص وتفاصيل بعضها الآخر متداولة حتى اليوم وحتى لو لم تكن هي التفاصيل الحقيقية للقصة أو التجربة الأولى؛ لكنها وضعت ونضجت وتداولها الناس لتلائم هذه التجربة الحياتي اليومية
ويعدّ المثل الشعبي أحد أهم عناصر التراث الفلسطيني الموغلة في القدم ومثلنا اليوم قيل إنَّ المثل لمالك بن زيد مناة بن تميم الذي أرسل أخاه سعدا ليورد الإبل فلم يُحْسِن واشتمل بكسائه ونام، فقال فيه أخوه هذا القول الذي صار مثلا يضرب في الـمُقَصِّر الذي يؤثر الراحة على العمل يُضَربُ لمن يقوم بعمل أو يؤدي مهمة بلا حذاقة أو إتقان وكما قيل
( نية المرء خير من عمله) فهل صدقت نوايانا وصلحُتْ أعمالنا وإذا تحدثنا في هذا المقال عن قوة الإرادة وذهبنا في حديثها مذهب خصال الحمد، فإنما نعني الإرادة المتوجهة إلى ما هو خير، ومن أفضل ما يمدح به الرجل أن يتوجه بعزمه القاطع إلى إظهار حق أو إقامة مصلحة وربما قضاء حاجة لمُعْسرْ أو تفريج كربة وطرق بابًا واسعًا من أبواب الخير فإن قضاء الحوائج وصنائع المعروف من أعظم أبواب البر فأهل المروءة والنجدة لا يمكنهم أن يروا مضطرا إلا أجابوه، ولا محتاجا إلا أعانوه، ولا ملهوفا إلا أغاثوه، فإن هذا من أصول المروءة كما قال ميمون بن مهران رحمه الله:
"أول المروءة طلاقة الوجه، والثاني التودد، والثالث قضاء الحوائج"
وقال الثوري: "المروءة: الإنصاف من النفس والتفضل
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(طُوبَى لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ، وَصَلُحَتْ سَرِيرَتُهُ، وَكَرُمَتْ عَلَانِيَتُهُ، وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ )
ما هكذا يا سعد تورد الإبل
يقال ان سعدا هذا كان له أخ يدعى مالك ورغم حمقه كان خبيرا برعي الإبل، فلما تزوج لم يخرج في صبيحة زفافه بالإبل فانتظره أخوه سعد ليخرج مع الإبل إلى المراعي. لكنه لم يخرج. فأخذها سعد وخرج بها إلى المراعي. فهاجت وماجت وتفرقت عليه فعاد إلى أخيه مالك غاضباً. وأخذ يناديه ولكن مالك لم يجبه فقال سعد متمثلاً ابيات من الشعر، موجها الكلام لمالك
يظل يوم وردها مزعفرا **** وهي خناطيل تدوس الأخضرا
فقالت: زوجته اجبه
فقال لها: بما أجيب
فقالت له: قل
أوردها سعد وسعد مشتمل **** ما هكذا ياسعد تورد الإبل
المعنى للمثل لمن يقوم بعمل أو يؤدي مهمة لا يجيد القيام بإنجازها لنقص المعرفة والخبرة وعدم المسؤولية والدقة والإتقان للمهام المخول له بأكمل وجه فمن هنا نشير إلى أهمية المثل وأثره على حياتنا في جميع المجالات المختلفة في الحياة سَواء كانت العلمية أو العملية وكما لا يمكننا ان ننجح في عمل ما الا بوجود الإخلاص والاتقان والمعرفة والتدريب والمسؤولية والكفاءة ليتسنى انجاز العمل وتحقيق النجاح دون خلل وخطأ مع الالتزام بقواعد العمل فكلما أحب الشخص عمله سعى إلى تأديته بجدارة ومهارة وتكريس كل طاقاته متقدمًا نحو النجاح والازدهار ومن المهم للفرد أن يعمل على تنمية مهاراته وقدراته الأساسية من خلال التدريب والمعرفة والتمرس عليها في عمله وحياته اليومية مما يجعله مبدع متفنن في مجال تخصصه ويستفيد منه المجتمع لكونه فعال فيجيب علينا أن نعمل بكل إخلاص وإتقان ومعرفة ومسؤولية ودقة وحسن التصرف في المهام والواجبات حسب الصلاحيات المخولة الينا ويكون الشخص مميزًا وقدوة حسنة ليترك أثرًا جميلاً في نفوس الناس ويرتقي بالمجتمع إلى المعالي والتقدم والازدهار والنجاح محققًا نتائج إيجابية وفعالة متميزًا في تحقيق الأهداف المرسومة والمرجوة ولا يكون إلا في إجادة الإخلاص والصدق والأمانة والإتقان والمسؤولية في العمل.
عبارة "لولا حاجتي لعلمتكم كيف تورد الإبل" هي تعبير يستخدم في اللغة العربية للإشارة إلى أن الشخص يستطيع القيام بشيء أو تعليم الآخرين كيفية القيام به، لكنه لا يفعل ذلك بسبب حاجته الحالية أو ظروفه التي تمنعه .
فالعبرة من مثلنا من لا يحسن القيام بعمله يوصف بأنه مقصر أو مهمل في أداء واجباته، ويمكن أن يوصف بـ الكسول أو المعقد، وقد يدل ذلك على افتقاره للمروءة كما في قول ابن المقفع في كتابه "الأدب الكبير" الذي يربط حسن العمل بحسن الكلام
ولست أقصد في حديثي هذا أولئك الذين يقفون لِيُجموا أنفسهم ويعدوها للعمل، ويحاسبوا أنفسهم، كما قال ابن القيم عن نوع من الواقفين وهو الذي: يقف ليجم نفسه ويعدها للسير فهذا وقفتُهُ سيرٌ ولا تضره الوقفةُ فإن لكل عمل شرةً ولكل شرةٍ فترة مَنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّتُهُ صَالِحَةً ، وَعَمَلُهُ عَمَلًا صَالِحًا لِوَجْهِ اللَّهِ ، وَإِلَّا كَانَ عَمَلًا فَاسِدًا ، أَوْ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ ، وَهُوَ الْبَاطِلُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (إنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى)